دراسات في الشريعة والعقيدة
عبودية الشهوات
(2)
سُبُل الدواء
د.عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف
تناول الكاتب ـ وفقه الله ـ فـي الحلقة الأولى الحديث عن الموقف الصحيح تجاه الشهوات ذاكراً أن المسلك العدل إزاءها هــو الـوسـطـيـة بين مـسـلـك أهــل الفجور ومسلك أصحاب الرهبانية، موضحاً أن الإسلام يراعي أحوال الناس ويدرك ما هـم عـلـيـه مــن الـغـرائـــز والشـهـــــوات؛ فهو يبيحها ويعترف بها ولكنه يضبطها ويهذبها، ثم تناول الحديث عن (شهوة النـسـاء). وفـي هـــــــذه الحلقة يتناول علاج هذه الشهوة، ويثنّي بصور أخرى من الشهوات وعلاجها.
علاج شهوة النساء:
بـعـد أن فصّلنا الحديث عن هذه الشهوة نورد علاجها وسبيل النجاة منها، وقد بسط أبو الـفـرج ابــن الجوزي في (ذم الهوى) وابن القيم في (روضة المحبين) الحديث عن العلاج، وأطنبا في وصفه وتشخيصه، وتميّز ابن الـجــوزي بإيراد علاج لكل مرحلة من مراحل هذه الشهوة، فجعل لـلـنظر المحرم علاجاً، وجعل للخلوة بالنساء علاجاً وهكذا. وأما ابن القيم فقد ساق خمسين وسيلة في علاج هذه الشهوة على سبيل الإجمال والعموم.
ومـمــا سطّره يراع أبي الفرج ابن الجوزي في هذا المقام: (واعلم أن أمراض العشق تختلف، فينبغي لذلك أن يختلف علاجها؛ فليس علاج من عنده بداية المرض كعلاج من انتهى به المرض نهايته، وإنـمـــا يُعـالـج مـن هذا المرض من لم يرتقِ إلى غايته؛ فإنه إذا بلغ الغاية أحدث الجنون والذهول، وتلك حالة لا تقبل العلاج)(1).
وقــال أيـضـاً: (فإن تكرار النظر قد نقش صورة المحبوب في القلب نقشاً متمكناً؛ وعلامة ذلك: امـتــلاء القلب بالحبيب؛ فكأنه يراه حالاّ في الصدر، وكأنه يضمه إليه عند النوم ويحادثه في الخلوة، فاعلم أن سبب هذا الطمع في نيل المطلوب، وكفى بالطمع مرضاً، وقلّ أن يقع الفـســــق إلا في المطموع فيه؛ فإن الإنسان لو رأى زوجة الملك فهويها لم يكد قلبـه يتـعـلــق بها؛ لأجل اليأس من مثلها. فأما من طمع في شيء فإن الطمع يحمله على طلبه، ويعذّبه إن لم يدركه..
وعلاج هذا المرض: العزم القوي على البعد عن المحبوب، والقطع الجازم على غض البصر عنه، وهجران الطمع فيه، وتوطين النفس على اليأس منه)(2).
وقـــــال في موضع ثالث: (ومما يُداوى به الباطن أن تفكّر، فتعلم أن محبوبك ليس كما في نفسك، فأعـمــل فكرك في عيوبه تسلُ؛ فإن الآدمي محشوّ بالأنجاس والأقذار، وإنما يرى العاشق معشوقه في حال الكمال، ولا يُصور له الهوى عيباً؛ لأن الحقائق لا تنكشف إلا مع الاعتدال، وسـلـطــان الهوى حاكم جائر يغطي المعايب، فيرى العاشق القبيح من معشوقه حسناً.
ولهذا قال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: (إذا أعجبت أحدَكم امرأةٌ فليذكر مناتنها)(3).
وأما مــا حرّره ابن القيم في سبيل التخلص من شراك هذه الشهوات، فنختار منها بعضها، فمن ذلك قوله:
(التـفـكـر فـي أنه لم يُخلق للهوى، وإنما هُيّئ لأمر عظيم لا يناله إلا بمعصيته للهوى كما قيل:
قد هيؤوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهملِ(4)
(أن يأنف لنفسه مــن ذل طاعة الهوى؛ فإنه ما أطاع أحد هواه قط إلا وجد في نفسه ذلاّ، ولا يـغـتـر بصـولـة أتباع الهوى وكِبرهم؛ فهم أذل الناس بواطنَ، قد جمعوا بين خصلتي الكبر والذل)(5).
(أن يعـلـم أن الـهـــــوى مـــا خالط شيئاً إلا أفسده، فإن وقع في العلم أخرجه إلى البدعة والضلالة وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء، وإن وقع في الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة، وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم وصدّه عن الحق، وإن وقع في الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين حيث يولّي بهواه ويعزل بهواه)(6).
(إن جهاد الهوى إن لم يكن أعـظــم مــن جـهــاد الكفّار فليس بدونه، قال رجل للحسن البصري ـ رحمه الله تعالى ـ: يا أبا سعيد! أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك. وسمعت شيخنا ابن تيمية يقول: (جهاد النفس أصـــــل جهاد الكفّار والمنافقين؛، فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولاً حتى يخرج إليهم)(7).
(إن اتباع الهوى يغلق عن العبد أبواب التوفيق، ويفتح عليه أبواب الخذلان، فتراه يلهج بأن الله لو وفّقه لكان كذا وكذا، وقد سدّ على نفسه طـــــرق الـتـوفـيــق باتباعه هواه. قال الفضيل بن عياض: من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عـنـــه مـــــــوارد التوفيق)(8).
(إن الـتـوحـيــد واتباع الهوى متضادان، فإن الهوى صنم ولكل عبد صنم في قلبه بحسب هواه، وإنما بعث الله رسله بكسر الأصنام وعبادته وحده لا شريك له، وليس مراد الله ـ تعالى ـ كسر الأصنام المجسّدة وترك الأصنام التي في القلب، بل المراد كسرها من القلب أولاً.. وتأمل قول الخليل: ((إذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ)) [الأنبياء: 52]، كيف تجده مطابقاً للتماثيل التي يهواها القلب ويعكف عليها ويعبدها من دون الله ـ تعالى ـ)(9).
(إن لكل عبد بداية ونهاية، فمن كانت بدايته اتباع الهوى، كانت نهايته الذل والصغار والحرمان والبلاء المتبوع بحسب ما اتبع هواه، بل يصير له ذلك في نهايته عذاباً يُعذّب به في قلبه كما قال القائل:
مآرب كانت في الشباب لأهلها عِذاباً فصارت في المشيب عَذاباً
فلو تأملت حال كــــــل ذي حالة سيئة زرية لرأيت بدايته الذهاب مع هواه وإيثاره على عقله، ومن كانت بدايـتـــــه مخالفة هواه وطاعة داعي رشده كانت نهايته العز والشرف والغنى والجاه عند الله وعند الناس. قيل للمهلب ابن أبي صفرة: بِمَ نلت ما نلت؟ قال: بطاعة الحزم وعصيان الهوى. فهذا في بداية الدنيا ونهايتها، وأما الآخرة فقد جعل الله ـ سبحانه ـ الجنة نهاية من خالف هواه، والنار نهاية من اتبع هواه)(10).
وبالجملة: فإنه ما من داء إلا ولــه دواء عَلِمه من علمه، وَجهِله من جهله، والمتعيّن على من ابتلي بشيء من هذه الشهوات أن يـبـــادر إلـى أســبــاب النجاة ووسائلها.. بالعزيمة الصادقة، والصبر والمصابرة، وعلو الهمة والاشتغال بمعالي الأمور والابتعاد عن سفاسفها، والمجاهدة في ذات الله ـ تعالى ـ، ونهي النفس عن الهوى وإصلاح الخواطر والإرادات، وصحبة الصالحين، ودوام التضرع إلى الله ـ تعالى ـ والانكسار بين يديه سبحانه.
شهوة المال:
اسـتـولـى عـلـى أفئدة كثير من الناس الولع بالمال، فأُشربوا حبه والتعلق به، فاستعبدهم الدرهم والديـنــــار، وصار هِجّيراهم ومقصودهم وجلّ حديثهم واهتمامهم، فإن أحبوا فلا يحبون إلا لأجل المال، وإن أبغضوا فلا يبغضون إلا لأجل المال: إن أُعطوا رضوا، وإن لم يُعطَوْا إذا هم يسخطون.
ولقد ذمّ الله ـ تعالى ـ الدنيا في كتابه في غير موضع، كقوله ـ تعالى ـ: ((وَمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا إلاَّ مَتَاعُ الغُرُورِ)) [الحديد: 20] وقوله ـ سبحانه ـ: ((اعْلَمُوا أَنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ)) [الحديد: 20].
وأما الأحاديث في ذم الدنيا وفضل الزهد فكثيرة جداً؛ منها حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قـــــــال: جلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المنبر، وجلسنا حوله، فقال: (إنّ مما أخاف عليكم من بعدي ما يُفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها) متفق عليه.
وعن أبي هريرة -رضي الله عــنـــه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخمـيـصــــة، إن أعطي رضي، وإن لم يُعطَ لم يرضَ) أخرجه البخاري.
وعن كعب بن عيا ض -رضي الله عنه- قا ل: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يـقــــــول: (إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال) أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
وعن كـعــب بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله: (ما ذئبان جائعان أُرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه) أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
وقد ورد عــــــن الحسن البصري ـ رحمه الله ـ: أنه قال: إياكم وما شغل من الدنيا؛ فإن الدنيا كثيرة الأشغال، لا يفتح رجل على نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب)(11).
وكان يقول أيـضـــــاً: (أهينوا الدنيا فو الله لأهنأ ما تكون إذا أهنتها)(12). وكان الحسن يحلف بالله ما أعز أحدٌ الدرهمَ إلا أذله الله)(13).
ولابن القيم ـ رحـمـــــه الله ـ كـلام نفـيس في الترغـيب بالزهـد في الدنيا، والإقبال على الآخـرة، نـورد منـه ما يلي:
(لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين:
نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها، وألم المزاحمة عليها والحرص عليها، وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد، وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحـسـرة والأسف؛ فطالبها لا ينفك من همّ قبل حصولها، وهمّ في حال الظفر بها، وغم وحزن بعد فواتها؛ فهذا أحد النظرين.
النظر الثاني: النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد، ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات، والتفاوت الذي بينه وبين ما ههنا؛ فهي كما قال الله ـ سبحانه ـ: ((وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى)) [الأعلى: 17] فهي خيرات كاملة دائمة، وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة).
ـ إلى أن قال ـ: (وقد توعّـــد الله ـ سبحانه ـ أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها وغفل عن آياته ولم يرجُ لقاءه فقال: ((إنَّ الَذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هـُــــمْ عَــــنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ(7)أُوْلَئِكَ مَاًوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)) [يونس: 7، 8] وعيّر ـ سبحانه ـ من رضي بالدنيا من المؤمنين فقال: ((يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَـبـِـيــلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إلاَّ قَلِيلٌ)) [التوبة: 38] وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة.
ويكفي في الزهد في الدنيا قوله ـ تعالى ـ: ((أَفَرَأَيْتَ إن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ (205) ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ (206) مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ)) [الشعراء: 205-207])(14).
وجاء في كتاب: (عدة الصابرين) لابن القيم ما يلي: (جميع الأمم المكذبة لأنبيائهم إنما حملهم على كفرهم وهلاكهم حب الدنيا، فإن الرسل لما نهوهم عن الشرك والمعاصي التي كانوا يكسبون بها الدنيا حملهم حبها على مخالفتهم وتكذيبهم؛ فكل خطيئة في العالم أصلها حب الدنيا... فحب الدنيا والرياسة هو الذي عمر النار بأهلها، والزهد في الدنيا والرياسة هو الذي عمر الجنة بأهلها، والسكر بحب الدنيا أعظم من السكر بشرب الخمر بكثير، وصاحب هذا السكر لا يفيق منه إلا في ظلمة اللحد... والدنيا تسحر العقول أعظم سحر.
قال مالك بن دينار: (اتقوا السحّارة، اتقوا السحّارة؛ فإنها تسحر قلوب العلماء).
وأقل ما في حبها أنه يلهي عن حب الله وذكره، ومن ألهاه ماله عن ذكر الله ـ تعالى ـ فهو من الخاسرين، وإذا لها القلب عن ذكر الله سكنه الشيطان وصرفه حيث أراد)(15).
وقد بالغ العلماء في التحذير من الاستمتاع بالدنيا والانكباب عليها، حتى جعلوا مجرد النظـر إلى الدنيـا ـ إن كان على سبيل استحسانها والركون إليها ـ مذموماً، كما وضّحه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله:
(النظر إلى الأشجار والخيل والبهائم إذا كان على وجه استحسان الدنيا والرياسة والمال فهو مذموم؛ لقول الله ـ تعالى ـ: ((وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى)) [طه: 131].
وأما إذا كان على وجه لا ينقص الدين، وإنما فيه راحة النفس فقط، كالنظر إلى الأزهار، فهذا من الباطل الذي يستعان به على الحق)(16).
إن الحرص على المال يكون على وجهين؛ كما قرر الحافظ ابن رجب بقوله:
(أحدهما: شدة محبة المال مع طلبه من وجوه مباحة، والمبالغة في طلبه والجد في تحصيله واكتسابه من وجوهه مع الجهد والمشقة...
ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع العمر الشريف فيما لا قيمة له ـ وقد يُمكّن صاحبه فيه اكتساب الدرجات العلى، والنعيم المقيم، فضيعه بالحرص في طلب رزق مضمون مقسوم لا يأتي منه إلا ما قُدّر وقُسـم؛ ثم لا ينتفـع به بل يتركـه لغيره ويرتحل عنه فيبقى حسابه عليه ونفعـه لغيـره، فيجمـع لمن لا يحمـده، ويقـدم على من لا يعـذره لكفـاه بـذلك ذماً للحرص؛ فالحريص يضيع زمانه الشريف، ويخاطر بنفسه في الأسفار وركوب الأخطار لجمع مال ينتفع به غيره.
النوع الثاني: من الحرص على المال أن يزيد على ما سبق ذكره في النوع الأول، حتى يطلب المال من الوجوه المحرمة، ويمنع الحقوق الواجبة، فهذا من الشح المذموم، قال الله ـ تعالى ـ: ((وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ)) [التغابن: 16].
وفي صحيح مسلم عن جابر ـ رضي الله عنه ـ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (اتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم: حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم)(17).
وإنما يصير حب المال مذموماً إذا كان سبباً في ارتكاب المعاصي أو ترك الواجبات، يقول شيخ الإسلام في هذا الصدد: (حب المال والشرف يفسد الدين، والذي يعاقب عليه الشخص هو الحب الذي يدعو إلى المعاصي مثل الظلم والكذب والفواحش، ولا ريب أن فرط الحرص على المال والرياسة يوجب ذلك، أما مجرد حب القلب إذا كان الإنسان يفعل ما أمر الله به ويترك ما نهى عنه، ويخاف مقام ربه، وينهى النفس عن الهوى؛ فإن الله ـ تعالى ـ لا يعاقب على مثل هذا إذا لم يكن معه عمل.
وجمع المال إذا قام فيه بالواجبات ولم يكتسبه من الحرام لا يعاقب عليه، لكن إخراج الفضل والاقتصار على الكفاية أفضل وأسلم، وأفرغ للقلب وأجمع للهم، وأنفع للدنيا والآخرة، وقد قال: (من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله، وجعل فقره في عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي راغمة)(18).
وينبغي التوسط إزاء المال بين الشره والانهماك عليه، وبين تركه والإعراض عنه؛ كما في حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فخطب الناس فقال: (لا والله ما أخشى عليكم إلا ما يُخرِج الله لكم من زهرة الدنيا)، فقال رجل: يا رسول الله! أوَ يأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم قال: كيف قلتَ؟ قال: يا رسول الله! أوَ يأتي الخير بالشر؟ فقال رسول الله: (إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً، أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس فثلطت وبالت، ثم اجترّت فعادت فأكلت، فمن أخذ مالاً بحقه بورك له فيه، ومن أخذ مالاً بغير حقه؛ فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع) متفق عليه.
وقد شرح ابن القيم هذا الحديث وبيّن المسلك الوسط تجاه المال فقال: (قوله: (إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يلم)) هذا من أحسن التمثيل المتضمن للتحذير من الدنيا والانهماك عليها والمسرة فيها، وذلك أن الماشية يروقها نبت الربيع فتأكل منه بأعينها فربما هلكت حبطاً، (والحبط انتفاخ بطن الدابة من الامتلاء أو من المرض)، فكذلك الشرِه في المال يقتله شرهه وحرصه، فإن لم يقتله قارب أن يقتله، وهو قوله: (أو يلم)، وكثير من أرباب الأموال إنما قتلهم أموالهم؛ فإنهم شرهوا في جمعها واحتاج إليها غيرهم، فلم يصلوا إليها إلا بقتلهم أو ما يقاربه من إذلالهم وقهرهم.
وقوله: (إلا آكلة الخضر) هذا تمثيل لمن أخذ من الدنيا حاجته، مثّله بالشاة الآكلة من الخضر بقدر حاجتها، أكلت حتى امتلأت خاصرتاها...
وفي قوله: (استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت) ثلاث فوائد: أحدها أنها لما أخذت حاجتها من المرعى تركته وبركت مستقبلة الشمس لتستمرئ بذلك ما أكلته. الثانية: أنها أعرضت عما يضرها من الشره في المرعى وأقبلت على ما ينفعها من استقبال الشمس التي يحصل لها بحرارتها إنضاح ما أكلته وإخراجه. الثالثة: أنها استفرغت بالبول والثلط ما جمعته من المرعى في بطنها فاستراحت بإخراجه، ولو بقي فيها لقتلها، فكذلك جامع المال مصلحته أن يفعل به كما فعلت هذه الشاة...
وفي هذا الحديث إشارة إلى الاعتدال والتوسط بين الشره في المرعى القاتل بكثرته، وبين الإعراض عنه وتركه بالكلية فتهلك جوعاً. وتضمّن الخبر أيضاً إرشاد المكثر من المال إلى ما يحفظ عليه قوته وصحته في بدنه وقلبه وهو الإخراج منه وإنفاقه ولا يحبسه فيضره حبسه)(19).
وإذا تقررت هذه الوسطية تجاه المال فإن على العلماء والدعاة خصوصاً أن يُعْنَوْا بتحقيق الكفاف والاستغناء عن الناس كما يُعْنَوْا بالزهد والتقلل من الدنيا؛ فإن استغناء العلماء عن الناس عموماً والحكام خصوصاً من أعظم الأسباب في حفظ مكانة العلماء وعظم شأنهم.
يقول سفيان الثوري ـ رحمه الله ـ: (لأن أخلّف عشرة آلاف درهم أحاسب عليها أحب إليّ من أن أحتاج إلى الناس... ولولا هذه الدراهم لتمندل بنا هؤلاء الملوك)(20).
يقول ابن الجوزي حاثاً على الاستغناء عن الناس: (ليس في الدنيا أنفع للعلماء من جمع المال للاستغناء عن الناس، فإنه إذا ضم إلى العلم حيز الكمال، وإن جمهور العلماء شغلهم العلم عن الكسب، فاحتاجوا إلى ما لا بد منه، وقلّ الصبر فدخلوا مداخل شانتهم وإن تأوّلوا فيها...
ولقد رأينا جماعة من المتصوفة والعلماء يغْشون الولاة لأجل نيل ما في أيديهم؛ فمنهم من يداهن ويرائي، ومنهم من يمدح بما لا يجوز، ومنهم من يسكت عن منكرات إلى غير ذلك من المداهنات، وسببها الفقر، فعلمنا أن كمال العز وبُعد الرياء إنما يكون في البعد عن العمال الظّلَمَة، ولم نرَ من صح له هذا إلا في أحد رجلين:
أما من كان له مال كسعيد بن المسيب كان يتجر في الزيت وغيره، وسفيان الثوري كانت له بضائع، وابن المبارك. وأما من كان شديد الصبر قنوعاً بما رزق ـ وإن لم يكفه ـ كبشر الحافي وأحمد بن حنبل؛ ومتى لم يجد الإنسان كصبر هذين، ولا كمال أولئك، فالظاهر تقلبه في المحن والآفات، وربما تلف دينه.
فعليك يا طالب العلم بالاجتهاد في جمع المال للغنى عن الناس؛ فإنه يجمع لك دينك، فما رأينا في الأغلب منافقاً في التدين والتزهد والتخشع، ولا آفة طرأت على عالم إلا بحبّ الدنيا، وغالب ذلك الفقر، فإن كان من له ما يكفيه ثم يطلب بتلك المخالطة الزيادة فذلك معدود في أهل الشّرَهِ، خارج عن حيّز العلماء)(21).
* والمقصود أن على العبد أن يقنع بالكفاف من هذا المال، مما يحتاجه في مطعمه ومشربه ومسكنه وملبسه ونحو ذلك، وأن يطلب ذلك من الله ـ تعالى ـ وحده ويرغب إليه فيه، وأن لا يكون سائلاً للمال بلسانه ـ إلا لضرورة ـ أو مستشرفاً إليه بقلبه.
وأما ما لا يحتاج إليه العبد فلا ينبغي له الاشتغال به؛ لأن ذلك يؤول إلى تعلق القلب بالمال واستعباده له، كما يفوت عمره في تحصيل رزق مقسوم، وقد يحمله الحرص على المال على اكتسابه بالحرام ومنع الحقوق الواجبة.
شهوة الرياسة:
شهوة حب الرياسة والمنصب إحدى الشهوات التي استعبدت كثيراً من الناس وأحكمت على أفئدتهم، فصارت الولايات والمناصب وما يتبعها من الشهرة والظهور مقصودهم ومرادهم.
وقد سبق إيراد حديث كعب بن مالك ـ رضي الله عنه ـ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (ما ذئبان جائعان أُرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه)(22).
يقول الحافظ ابن رجب ـ رحمه الله ـ في شرح هذا الحديث: (فأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن حرص المرء على المال والشرف إفساد لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم، بل إما أن يكون مساوياً وإما أكثر، يشير أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل، كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا القليل. فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا).
ـ إلى أن قال ـ: (وأما حرص المرء على الشرف فهو أشد إهلاكاً من الحرص على المال؛ فإن طلب شرف الدنيا والرفعة فيها، والرياسة على الناس والعلو في الأرض أضر على العبد من طلب المال، وضرره أعظم والزهد فيه أصعب؛ فإن المال يبذل في طلب الرياسة والشرف)(23).
ثم ذكر ـ رحمه الله ـ أقسام الحرص على الشرف فقال: (والحرص على الشرف قسمان:
أحدها: طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال، وهذا خطر جداً، وهو في الغالب يمنع خير الآخرة وشرفها وكرامتها وعزها. قال الله ـ تعالى ـ: ((تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُواً فِي الأَرْضِ وَلا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)) [القصص: 83]، وقلّ من يحرص على رياسة الدنيا بطلب الولايات فيوفق بل يوكَل إلى نفسه).
إلى أن قال ـ: (ومن دقيق آفات حب الشرف: طلب الولايات والحرص عليها، وهو باب غامض لا يعرفه إلا العلماء بالله العارفون به المحبون له....
واعلم أن حب الشرف بالحرص على نفوذ الأمر والنهي، وتدبير أمر الناس إذا قُصِدَ بذلك مجرد علو المنزلة على الخلق، والتعاظم عليهم، وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس وافتقارهم إليه، وذلهم له في طلب حوائجهم منه؛ فهذا نفسه مزاحمة لربوبية الله وإلهيته.
القسم الثاني: طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية كالعلم والعمل والزهد؛ فهذا أفحش من الأول، وأقبح وأشد فساداً وخطراً؛ فإن العلم والعمل والزهد إنما يُطلب به ما عند الله من الدرجات العلى والنعيم المقيم، والقربى منه والزلفى لديه...)(24).
ومما يؤكد خطر هذه الشهوة أن جنس بني آدم مولع بحب الرياسة والظهور، كما بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: (إن الإنسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس؛ رأى الواحد يريد نفسه أن تطاع وتعلو بحسب الإمكان، والنفوس مشحونة بحب العلو والرئاسة بحسب إمكانها، فتجده يوالي من يوافقه على هواه، ويعادي من يخالفه في هواه، وإنما معبوده ما يهواه وما يريده)...
إلى أن قال ـ: (فإن كان مطاعاً مسلماً طلب أن يطاع في أغراضه وإن كان فيها ما هو ذنب ومعصية لله، ويكون من أطاعه أحب إليه وأعز عنده ممن أطاع الله وخالف هواه، وهذه شعبة من حال فرعون وسائر المكذبين للرسل.
وإن كان عالماً أو شيخاً أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره، وربما أبغض نظيره حسداً وبغياً..)(25).
إن حب الرئاسة وطلبها لا ينفك عن مفاسد متعددة وشرور متنوعة، وقد أشار ابن رجب إلى بعضها بقوله: (واعلم أن الحرص على الشرف يستلزم ضرراً عظيماً، قبل وقوعه في السعي في أسبابه، وبعد وقوعه بالحرص العظيم الذي يقع فيه صاحب الولاية من الظلم والتكبر، وغير ذلك من المفاسد)(26).
وقال في موضع آخر: (إن حب المال والرئاسة والحرص عليهما يفسد دين المرء حتى لا يبقى منه إلا ما شاء الله... والنفس تحب الرفعة والعلو على أبناء جنسها، ومن هنا نشأ الكبر والحسد)(27).
وذكر ابن القيم ـ رحمه الله ـ بعض مفاسد هذه الشهوة، فقال:
(إن طلاب الرياسة ليسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض، وتعبّد القلوب لهم، وميلها إليهم، ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم، فترتب على هذا المطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والفتنة والحمية للنفس دون حق الله، وتعظيم من حقّره الله، واحتقار من أكرمه الله، ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تُنال إلا به وبأضعافه من المفاسد، والرؤساء في عمىً عن هذا؛ فإذا كُشف الغطاء تبيّن لهم فساد ما كانوا عليه، ولا سيما إذا حُشِروا في صُوَرِ الذرّ يطؤهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتصغيراً كما صغّروا أمر الله وحقروا عباده)(28).
وإذا تقرر ذم حب الرياسة وبيان مفاسدها، فإن حب الإمارة للدعوة إلى الله ـ تعالى ـ يفارق حب الرياسة؛ فإن مقصود هذه الإمارة تعظيم الله ـ تعالى ـ وأمره، وأما مقصود حب الرياسة فهو تعظيم النفوس والسعي في حظوظها، وأئمة العدل وقضاتهم لا يدعون إلى تعظيم نفوسهم البتة، بل إلى تعظيم الله وحده وإفراده بالعبودية، ومنهم من كان لا يريد الولاية إلا للاستعانة بها على الدعوة إلى الله وحده. فمن سأل ربه أن يجعله للمتقين إماماً يقتدي به المتقون، كما اقتدى هو بالمتقين لم يضره ذلك، بل يُحمد عليه؛ لأنه داعٍ إلى الله يحب أن يعبد ويطاع، فهو يحب ما يكون عوناً على ذلك موصلاً إليه (29).
إن على أهل العلم وطلابه أن يحذروا من شهوة حب الرياسة والشهرة، فإنه داء عضال ينبغي المسارعة في علاجه بالتوبة إلى الله ـ تعالى ـ وتزكية النفس ومحاسبتها.
يقول سفيان الثوري ـ رحمه الله ـ: (الرياسة أحب إلى القراء من الذهب الأحمر)(30).
وقد تحدث أبو الفرج ابن الجوزي عن أولئك العلماء المولعين بالرياسات والشهرة فقال: (واليوم صارت الرياسات من كل جانب، وما تتمكن الرياسات حتى يتمكن من القلب: الغفلة، ورؤية الخلق، ونسيان الحق؛ فحينئذ تطلب الرياسة على أهل الدنيا.
ولقد رأيـت مـن الناس عجباً حتى من يتزيا بالعلم، إن رآني أمشي وحدي أنكر عليّ، وإن رآني أزور فـقــيـراً عظّم ذلك، وإن رآني أنبسط بتبسم نقصت من عينه، فقلت: فوا عجباً هذه كانت طريق الـرسـول -صلى الله عليه وسلم- والصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، فصارت أحوال الخلق نواميس لإقـامـــة الجاه، لا جَرَمَ واللهِ! سقطتم من عين الحق، فأسقطكم من عين الخلق...
فـالتفِـتـــوا إخواني إلى إصلاح النيات، وترك التزين للخلق، ولتكن عُمدتكم الاستقامة مع الحق؛ فبذلك صعد السلف وسعدوا)(31).
وفي ختام هـــذه المقالة نسأل الله ـ تعالى ـ أن يرزقنا الهدى والتقوى والعفاف والغنى، وأن يجنبنا شهوات الغي ومضلات الهوى، وبالله التوفيق.
الهوامش:
(1) ذم الهوى، ص 498.
(2) ذم الهوى، ص 501، 502، باختصار يسير، وانظر ص 537.
(3) ذم الهوى، ص 546، 547، باختصار يسير.
(4) روضة المحبين ص 472.
(5) المرجع السابق، ص473.
(6) المرجع السابق 474.
(7) المرجع السابق، 478.
(8) المرجع السابق 479.
(9) المرجع السابق، ص481، 482.
(10) ذم الهوى، ص 483، 484.
(11) أخرجه ابن المبارك في الزهد، ص 189.
(12) سير أعلام النبلاء، 4/579.
(13) أخرجه أبو نعيم في الحلية، 2/152، وانظر: سير أعلام النبلاء، 4/576.
(14) الفوائد، ص 87-89، باختصار.
(15) عدة الصابرين، ص 185، 186، باختصار.
(16) مختصر الفتاوى المصرية، ص 29، وانظر: شجرة المعارف والأحوال، للعز بن عبد السلام، ص 7.
(17) شرح حديث (ما ذئبان جائعان...) ص 7-11، باختصار.
(18) مختصر الفتاوى المصرية، ص 493، وانظر ص 95، وانظر مجموع الفتاوى، 10/189، 190، ومختصر منهاج القاصدين، لأحمد بن قدامة، ص 195.
(19) عدة الصابرين، ص 198، 199، باختصار.
(20) أخرجه أبو نعيم في الحلية، 6/381.
(21) شرح حديث ما (ذئبان جائعان) ص 7، 13، باختصار.
(22) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
(23) شرح حديث (ما ذئبان جائعان)، ص 7، 13، باختصار.
(24) شرح حديث (ما ذئبان جائعان) ص 13، 15، 16، 20، باختصار.
(25) مجموع الفتاوى، 8/218،-باختصار.
(26) شرح حديث (ما ذئبان جائعان)، ص 14.
(27) المرجع السابق، ص 29.
(28) كتاب الروح، ص 433، 434.
(29) انظر: كتاب شرح حديث (ما ذئبان جائعان)، ص 19، وكتاب الروح، ص 432.
(30) كتاب الورع، للإمام أحمد بن حنبل، ص 91.
(31) صيد الخاطر، ص 227، وانظر ص 360، وانظر: أخلاق العلماء للآجري، ص 157.
عبودية الشهوات
(2)
سُبُل الدواء
د.عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف
تناول الكاتب ـ وفقه الله ـ فـي الحلقة الأولى الحديث عن الموقف الصحيح تجاه الشهوات ذاكراً أن المسلك العدل إزاءها هــو الـوسـطـيـة بين مـسـلـك أهــل الفجور ومسلك أصحاب الرهبانية، موضحاً أن الإسلام يراعي أحوال الناس ويدرك ما هـم عـلـيـه مــن الـغـرائـــز والشـهـــــوات؛ فهو يبيحها ويعترف بها ولكنه يضبطها ويهذبها، ثم تناول الحديث عن (شهوة النـسـاء). وفـي هـــــــذه الحلقة يتناول علاج هذه الشهوة، ويثنّي بصور أخرى من الشهوات وعلاجها.
علاج شهوة النساء:
بـعـد أن فصّلنا الحديث عن هذه الشهوة نورد علاجها وسبيل النجاة منها، وقد بسط أبو الـفـرج ابــن الجوزي في (ذم الهوى) وابن القيم في (روضة المحبين) الحديث عن العلاج، وأطنبا في وصفه وتشخيصه، وتميّز ابن الـجــوزي بإيراد علاج لكل مرحلة من مراحل هذه الشهوة، فجعل لـلـنظر المحرم علاجاً، وجعل للخلوة بالنساء علاجاً وهكذا. وأما ابن القيم فقد ساق خمسين وسيلة في علاج هذه الشهوة على سبيل الإجمال والعموم.
ومـمــا سطّره يراع أبي الفرج ابن الجوزي في هذا المقام: (واعلم أن أمراض العشق تختلف، فينبغي لذلك أن يختلف علاجها؛ فليس علاج من عنده بداية المرض كعلاج من انتهى به المرض نهايته، وإنـمـــا يُعـالـج مـن هذا المرض من لم يرتقِ إلى غايته؛ فإنه إذا بلغ الغاية أحدث الجنون والذهول، وتلك حالة لا تقبل العلاج)(1).
وقــال أيـضـاً: (فإن تكرار النظر قد نقش صورة المحبوب في القلب نقشاً متمكناً؛ وعلامة ذلك: امـتــلاء القلب بالحبيب؛ فكأنه يراه حالاّ في الصدر، وكأنه يضمه إليه عند النوم ويحادثه في الخلوة، فاعلم أن سبب هذا الطمع في نيل المطلوب، وكفى بالطمع مرضاً، وقلّ أن يقع الفـســــق إلا في المطموع فيه؛ فإن الإنسان لو رأى زوجة الملك فهويها لم يكد قلبـه يتـعـلــق بها؛ لأجل اليأس من مثلها. فأما من طمع في شيء فإن الطمع يحمله على طلبه، ويعذّبه إن لم يدركه..
وعلاج هذا المرض: العزم القوي على البعد عن المحبوب، والقطع الجازم على غض البصر عنه، وهجران الطمع فيه، وتوطين النفس على اليأس منه)(2).
وقـــــال في موضع ثالث: (ومما يُداوى به الباطن أن تفكّر، فتعلم أن محبوبك ليس كما في نفسك، فأعـمــل فكرك في عيوبه تسلُ؛ فإن الآدمي محشوّ بالأنجاس والأقذار، وإنما يرى العاشق معشوقه في حال الكمال، ولا يُصور له الهوى عيباً؛ لأن الحقائق لا تنكشف إلا مع الاعتدال، وسـلـطــان الهوى حاكم جائر يغطي المعايب، فيرى العاشق القبيح من معشوقه حسناً.
ولهذا قال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: (إذا أعجبت أحدَكم امرأةٌ فليذكر مناتنها)(3).
وأما مــا حرّره ابن القيم في سبيل التخلص من شراك هذه الشهوات، فنختار منها بعضها، فمن ذلك قوله:
(التـفـكـر فـي أنه لم يُخلق للهوى، وإنما هُيّئ لأمر عظيم لا يناله إلا بمعصيته للهوى كما قيل:
قد هيؤوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهملِ(4)
(أن يأنف لنفسه مــن ذل طاعة الهوى؛ فإنه ما أطاع أحد هواه قط إلا وجد في نفسه ذلاّ، ولا يـغـتـر بصـولـة أتباع الهوى وكِبرهم؛ فهم أذل الناس بواطنَ، قد جمعوا بين خصلتي الكبر والذل)(5).
(أن يعـلـم أن الـهـــــوى مـــا خالط شيئاً إلا أفسده، فإن وقع في العلم أخرجه إلى البدعة والضلالة وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء، وإن وقع في الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة، وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم وصدّه عن الحق، وإن وقع في الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين حيث يولّي بهواه ويعزل بهواه)(6).
(إن جهاد الهوى إن لم يكن أعـظــم مــن جـهــاد الكفّار فليس بدونه، قال رجل للحسن البصري ـ رحمه الله تعالى ـ: يا أبا سعيد! أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك. وسمعت شيخنا ابن تيمية يقول: (جهاد النفس أصـــــل جهاد الكفّار والمنافقين؛، فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولاً حتى يخرج إليهم)(7).
(إن اتباع الهوى يغلق عن العبد أبواب التوفيق، ويفتح عليه أبواب الخذلان، فتراه يلهج بأن الله لو وفّقه لكان كذا وكذا، وقد سدّ على نفسه طـــــرق الـتـوفـيــق باتباعه هواه. قال الفضيل بن عياض: من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عـنـــه مـــــــوارد التوفيق)(8).
(إن الـتـوحـيــد واتباع الهوى متضادان، فإن الهوى صنم ولكل عبد صنم في قلبه بحسب هواه، وإنما بعث الله رسله بكسر الأصنام وعبادته وحده لا شريك له، وليس مراد الله ـ تعالى ـ كسر الأصنام المجسّدة وترك الأصنام التي في القلب، بل المراد كسرها من القلب أولاً.. وتأمل قول الخليل: ((إذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ)) [الأنبياء: 52]، كيف تجده مطابقاً للتماثيل التي يهواها القلب ويعكف عليها ويعبدها من دون الله ـ تعالى ـ)(9).
(إن لكل عبد بداية ونهاية، فمن كانت بدايته اتباع الهوى، كانت نهايته الذل والصغار والحرمان والبلاء المتبوع بحسب ما اتبع هواه، بل يصير له ذلك في نهايته عذاباً يُعذّب به في قلبه كما قال القائل:
مآرب كانت في الشباب لأهلها عِذاباً فصارت في المشيب عَذاباً
فلو تأملت حال كــــــل ذي حالة سيئة زرية لرأيت بدايته الذهاب مع هواه وإيثاره على عقله، ومن كانت بدايـتـــــه مخالفة هواه وطاعة داعي رشده كانت نهايته العز والشرف والغنى والجاه عند الله وعند الناس. قيل للمهلب ابن أبي صفرة: بِمَ نلت ما نلت؟ قال: بطاعة الحزم وعصيان الهوى. فهذا في بداية الدنيا ونهايتها، وأما الآخرة فقد جعل الله ـ سبحانه ـ الجنة نهاية من خالف هواه، والنار نهاية من اتبع هواه)(10).
وبالجملة: فإنه ما من داء إلا ولــه دواء عَلِمه من علمه، وَجهِله من جهله، والمتعيّن على من ابتلي بشيء من هذه الشهوات أن يـبـــادر إلـى أســبــاب النجاة ووسائلها.. بالعزيمة الصادقة، والصبر والمصابرة، وعلو الهمة والاشتغال بمعالي الأمور والابتعاد عن سفاسفها، والمجاهدة في ذات الله ـ تعالى ـ، ونهي النفس عن الهوى وإصلاح الخواطر والإرادات، وصحبة الصالحين، ودوام التضرع إلى الله ـ تعالى ـ والانكسار بين يديه سبحانه.
شهوة المال:
اسـتـولـى عـلـى أفئدة كثير من الناس الولع بالمال، فأُشربوا حبه والتعلق به، فاستعبدهم الدرهم والديـنــــار، وصار هِجّيراهم ومقصودهم وجلّ حديثهم واهتمامهم، فإن أحبوا فلا يحبون إلا لأجل المال، وإن أبغضوا فلا يبغضون إلا لأجل المال: إن أُعطوا رضوا، وإن لم يُعطَوْا إذا هم يسخطون.
ولقد ذمّ الله ـ تعالى ـ الدنيا في كتابه في غير موضع، كقوله ـ تعالى ـ: ((وَمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا إلاَّ مَتَاعُ الغُرُورِ)) [الحديد: 20] وقوله ـ سبحانه ـ: ((اعْلَمُوا أَنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ)) [الحديد: 20].
وأما الأحاديث في ذم الدنيا وفضل الزهد فكثيرة جداً؛ منها حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قـــــــال: جلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المنبر، وجلسنا حوله، فقال: (إنّ مما أخاف عليكم من بعدي ما يُفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها) متفق عليه.
وعن أبي هريرة -رضي الله عــنـــه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخمـيـصــــة، إن أعطي رضي، وإن لم يُعطَ لم يرضَ) أخرجه البخاري.
وعن كعب بن عيا ض -رضي الله عنه- قا ل: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يـقــــــول: (إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال) أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
وعن كـعــب بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله: (ما ذئبان جائعان أُرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه) أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
وقد ورد عــــــن الحسن البصري ـ رحمه الله ـ: أنه قال: إياكم وما شغل من الدنيا؛ فإن الدنيا كثيرة الأشغال، لا يفتح رجل على نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب)(11).
وكان يقول أيـضـــــاً: (أهينوا الدنيا فو الله لأهنأ ما تكون إذا أهنتها)(12). وكان الحسن يحلف بالله ما أعز أحدٌ الدرهمَ إلا أذله الله)(13).
ولابن القيم ـ رحـمـــــه الله ـ كـلام نفـيس في الترغـيب بالزهـد في الدنيا، والإقبال على الآخـرة، نـورد منـه ما يلي:
(لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين:
نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها، وألم المزاحمة عليها والحرص عليها، وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد، وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحـسـرة والأسف؛ فطالبها لا ينفك من همّ قبل حصولها، وهمّ في حال الظفر بها، وغم وحزن بعد فواتها؛ فهذا أحد النظرين.
النظر الثاني: النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد، ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات، والتفاوت الذي بينه وبين ما ههنا؛ فهي كما قال الله ـ سبحانه ـ: ((وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى)) [الأعلى: 17] فهي خيرات كاملة دائمة، وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة).
ـ إلى أن قال ـ: (وقد توعّـــد الله ـ سبحانه ـ أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها وغفل عن آياته ولم يرجُ لقاءه فقال: ((إنَّ الَذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هـُــــمْ عَــــنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ(7)أُوْلَئِكَ مَاًوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)) [يونس: 7، 8] وعيّر ـ سبحانه ـ من رضي بالدنيا من المؤمنين فقال: ((يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَـبـِـيــلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إلاَّ قَلِيلٌ)) [التوبة: 38] وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة.
ويكفي في الزهد في الدنيا قوله ـ تعالى ـ: ((أَفَرَأَيْتَ إن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ (205) ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ (206) مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ)) [الشعراء: 205-207])(14).
وجاء في كتاب: (عدة الصابرين) لابن القيم ما يلي: (جميع الأمم المكذبة لأنبيائهم إنما حملهم على كفرهم وهلاكهم حب الدنيا، فإن الرسل لما نهوهم عن الشرك والمعاصي التي كانوا يكسبون بها الدنيا حملهم حبها على مخالفتهم وتكذيبهم؛ فكل خطيئة في العالم أصلها حب الدنيا... فحب الدنيا والرياسة هو الذي عمر النار بأهلها، والزهد في الدنيا والرياسة هو الذي عمر الجنة بأهلها، والسكر بحب الدنيا أعظم من السكر بشرب الخمر بكثير، وصاحب هذا السكر لا يفيق منه إلا في ظلمة اللحد... والدنيا تسحر العقول أعظم سحر.
قال مالك بن دينار: (اتقوا السحّارة، اتقوا السحّارة؛ فإنها تسحر قلوب العلماء).
وأقل ما في حبها أنه يلهي عن حب الله وذكره، ومن ألهاه ماله عن ذكر الله ـ تعالى ـ فهو من الخاسرين، وإذا لها القلب عن ذكر الله سكنه الشيطان وصرفه حيث أراد)(15).
وقد بالغ العلماء في التحذير من الاستمتاع بالدنيا والانكباب عليها، حتى جعلوا مجرد النظـر إلى الدنيـا ـ إن كان على سبيل استحسانها والركون إليها ـ مذموماً، كما وضّحه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله:
(النظر إلى الأشجار والخيل والبهائم إذا كان على وجه استحسان الدنيا والرياسة والمال فهو مذموم؛ لقول الله ـ تعالى ـ: ((وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى)) [طه: 131].
وأما إذا كان على وجه لا ينقص الدين، وإنما فيه راحة النفس فقط، كالنظر إلى الأزهار، فهذا من الباطل الذي يستعان به على الحق)(16).
إن الحرص على المال يكون على وجهين؛ كما قرر الحافظ ابن رجب بقوله:
(أحدهما: شدة محبة المال مع طلبه من وجوه مباحة، والمبالغة في طلبه والجد في تحصيله واكتسابه من وجوهه مع الجهد والمشقة...
ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع العمر الشريف فيما لا قيمة له ـ وقد يُمكّن صاحبه فيه اكتساب الدرجات العلى، والنعيم المقيم، فضيعه بالحرص في طلب رزق مضمون مقسوم لا يأتي منه إلا ما قُدّر وقُسـم؛ ثم لا ينتفـع به بل يتركـه لغيره ويرتحل عنه فيبقى حسابه عليه ونفعـه لغيـره، فيجمـع لمن لا يحمـده، ويقـدم على من لا يعـذره لكفـاه بـذلك ذماً للحرص؛ فالحريص يضيع زمانه الشريف، ويخاطر بنفسه في الأسفار وركوب الأخطار لجمع مال ينتفع به غيره.
النوع الثاني: من الحرص على المال أن يزيد على ما سبق ذكره في النوع الأول، حتى يطلب المال من الوجوه المحرمة، ويمنع الحقوق الواجبة، فهذا من الشح المذموم، قال الله ـ تعالى ـ: ((وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ)) [التغابن: 16].
وفي صحيح مسلم عن جابر ـ رضي الله عنه ـ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (اتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم: حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم)(17).
وإنما يصير حب المال مذموماً إذا كان سبباً في ارتكاب المعاصي أو ترك الواجبات، يقول شيخ الإسلام في هذا الصدد: (حب المال والشرف يفسد الدين، والذي يعاقب عليه الشخص هو الحب الذي يدعو إلى المعاصي مثل الظلم والكذب والفواحش، ولا ريب أن فرط الحرص على المال والرياسة يوجب ذلك، أما مجرد حب القلب إذا كان الإنسان يفعل ما أمر الله به ويترك ما نهى عنه، ويخاف مقام ربه، وينهى النفس عن الهوى؛ فإن الله ـ تعالى ـ لا يعاقب على مثل هذا إذا لم يكن معه عمل.
وجمع المال إذا قام فيه بالواجبات ولم يكتسبه من الحرام لا يعاقب عليه، لكن إخراج الفضل والاقتصار على الكفاية أفضل وأسلم، وأفرغ للقلب وأجمع للهم، وأنفع للدنيا والآخرة، وقد قال: (من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله، وجعل فقره في عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي راغمة)(18).
وينبغي التوسط إزاء المال بين الشره والانهماك عليه، وبين تركه والإعراض عنه؛ كما في حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فخطب الناس فقال: (لا والله ما أخشى عليكم إلا ما يُخرِج الله لكم من زهرة الدنيا)، فقال رجل: يا رسول الله! أوَ يأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم قال: كيف قلتَ؟ قال: يا رسول الله! أوَ يأتي الخير بالشر؟ فقال رسول الله: (إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً، أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس فثلطت وبالت، ثم اجترّت فعادت فأكلت، فمن أخذ مالاً بحقه بورك له فيه، ومن أخذ مالاً بغير حقه؛ فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع) متفق عليه.
وقد شرح ابن القيم هذا الحديث وبيّن المسلك الوسط تجاه المال فقال: (قوله: (إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يلم)) هذا من أحسن التمثيل المتضمن للتحذير من الدنيا والانهماك عليها والمسرة فيها، وذلك أن الماشية يروقها نبت الربيع فتأكل منه بأعينها فربما هلكت حبطاً، (والحبط انتفاخ بطن الدابة من الامتلاء أو من المرض)، فكذلك الشرِه في المال يقتله شرهه وحرصه، فإن لم يقتله قارب أن يقتله، وهو قوله: (أو يلم)، وكثير من أرباب الأموال إنما قتلهم أموالهم؛ فإنهم شرهوا في جمعها واحتاج إليها غيرهم، فلم يصلوا إليها إلا بقتلهم أو ما يقاربه من إذلالهم وقهرهم.
وقوله: (إلا آكلة الخضر) هذا تمثيل لمن أخذ من الدنيا حاجته، مثّله بالشاة الآكلة من الخضر بقدر حاجتها، أكلت حتى امتلأت خاصرتاها...
وفي قوله: (استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت) ثلاث فوائد: أحدها أنها لما أخذت حاجتها من المرعى تركته وبركت مستقبلة الشمس لتستمرئ بذلك ما أكلته. الثانية: أنها أعرضت عما يضرها من الشره في المرعى وأقبلت على ما ينفعها من استقبال الشمس التي يحصل لها بحرارتها إنضاح ما أكلته وإخراجه. الثالثة: أنها استفرغت بالبول والثلط ما جمعته من المرعى في بطنها فاستراحت بإخراجه، ولو بقي فيها لقتلها، فكذلك جامع المال مصلحته أن يفعل به كما فعلت هذه الشاة...
وفي هذا الحديث إشارة إلى الاعتدال والتوسط بين الشره في المرعى القاتل بكثرته، وبين الإعراض عنه وتركه بالكلية فتهلك جوعاً. وتضمّن الخبر أيضاً إرشاد المكثر من المال إلى ما يحفظ عليه قوته وصحته في بدنه وقلبه وهو الإخراج منه وإنفاقه ولا يحبسه فيضره حبسه)(19).
وإذا تقررت هذه الوسطية تجاه المال فإن على العلماء والدعاة خصوصاً أن يُعْنَوْا بتحقيق الكفاف والاستغناء عن الناس كما يُعْنَوْا بالزهد والتقلل من الدنيا؛ فإن استغناء العلماء عن الناس عموماً والحكام خصوصاً من أعظم الأسباب في حفظ مكانة العلماء وعظم شأنهم.
يقول سفيان الثوري ـ رحمه الله ـ: (لأن أخلّف عشرة آلاف درهم أحاسب عليها أحب إليّ من أن أحتاج إلى الناس... ولولا هذه الدراهم لتمندل بنا هؤلاء الملوك)(20).
يقول ابن الجوزي حاثاً على الاستغناء عن الناس: (ليس في الدنيا أنفع للعلماء من جمع المال للاستغناء عن الناس، فإنه إذا ضم إلى العلم حيز الكمال، وإن جمهور العلماء شغلهم العلم عن الكسب، فاحتاجوا إلى ما لا بد منه، وقلّ الصبر فدخلوا مداخل شانتهم وإن تأوّلوا فيها...
ولقد رأينا جماعة من المتصوفة والعلماء يغْشون الولاة لأجل نيل ما في أيديهم؛ فمنهم من يداهن ويرائي، ومنهم من يمدح بما لا يجوز، ومنهم من يسكت عن منكرات إلى غير ذلك من المداهنات، وسببها الفقر، فعلمنا أن كمال العز وبُعد الرياء إنما يكون في البعد عن العمال الظّلَمَة، ولم نرَ من صح له هذا إلا في أحد رجلين:
أما من كان له مال كسعيد بن المسيب كان يتجر في الزيت وغيره، وسفيان الثوري كانت له بضائع، وابن المبارك. وأما من كان شديد الصبر قنوعاً بما رزق ـ وإن لم يكفه ـ كبشر الحافي وأحمد بن حنبل؛ ومتى لم يجد الإنسان كصبر هذين، ولا كمال أولئك، فالظاهر تقلبه في المحن والآفات، وربما تلف دينه.
فعليك يا طالب العلم بالاجتهاد في جمع المال للغنى عن الناس؛ فإنه يجمع لك دينك، فما رأينا في الأغلب منافقاً في التدين والتزهد والتخشع، ولا آفة طرأت على عالم إلا بحبّ الدنيا، وغالب ذلك الفقر، فإن كان من له ما يكفيه ثم يطلب بتلك المخالطة الزيادة فذلك معدود في أهل الشّرَهِ، خارج عن حيّز العلماء)(21).
* والمقصود أن على العبد أن يقنع بالكفاف من هذا المال، مما يحتاجه في مطعمه ومشربه ومسكنه وملبسه ونحو ذلك، وأن يطلب ذلك من الله ـ تعالى ـ وحده ويرغب إليه فيه، وأن لا يكون سائلاً للمال بلسانه ـ إلا لضرورة ـ أو مستشرفاً إليه بقلبه.
وأما ما لا يحتاج إليه العبد فلا ينبغي له الاشتغال به؛ لأن ذلك يؤول إلى تعلق القلب بالمال واستعباده له، كما يفوت عمره في تحصيل رزق مقسوم، وقد يحمله الحرص على المال على اكتسابه بالحرام ومنع الحقوق الواجبة.
شهوة الرياسة:
شهوة حب الرياسة والمنصب إحدى الشهوات التي استعبدت كثيراً من الناس وأحكمت على أفئدتهم، فصارت الولايات والمناصب وما يتبعها من الشهرة والظهور مقصودهم ومرادهم.
وقد سبق إيراد حديث كعب بن مالك ـ رضي الله عنه ـ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (ما ذئبان جائعان أُرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه)(22).
يقول الحافظ ابن رجب ـ رحمه الله ـ في شرح هذا الحديث: (فأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن حرص المرء على المال والشرف إفساد لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم، بل إما أن يكون مساوياً وإما أكثر، يشير أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل، كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا القليل. فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا).
ـ إلى أن قال ـ: (وأما حرص المرء على الشرف فهو أشد إهلاكاً من الحرص على المال؛ فإن طلب شرف الدنيا والرفعة فيها، والرياسة على الناس والعلو في الأرض أضر على العبد من طلب المال، وضرره أعظم والزهد فيه أصعب؛ فإن المال يبذل في طلب الرياسة والشرف)(23).
ثم ذكر ـ رحمه الله ـ أقسام الحرص على الشرف فقال: (والحرص على الشرف قسمان:
أحدها: طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال، وهذا خطر جداً، وهو في الغالب يمنع خير الآخرة وشرفها وكرامتها وعزها. قال الله ـ تعالى ـ: ((تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُواً فِي الأَرْضِ وَلا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)) [القصص: 83]، وقلّ من يحرص على رياسة الدنيا بطلب الولايات فيوفق بل يوكَل إلى نفسه).
إلى أن قال ـ: (ومن دقيق آفات حب الشرف: طلب الولايات والحرص عليها، وهو باب غامض لا يعرفه إلا العلماء بالله العارفون به المحبون له....
واعلم أن حب الشرف بالحرص على نفوذ الأمر والنهي، وتدبير أمر الناس إذا قُصِدَ بذلك مجرد علو المنزلة على الخلق، والتعاظم عليهم، وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس وافتقارهم إليه، وذلهم له في طلب حوائجهم منه؛ فهذا نفسه مزاحمة لربوبية الله وإلهيته.
القسم الثاني: طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية كالعلم والعمل والزهد؛ فهذا أفحش من الأول، وأقبح وأشد فساداً وخطراً؛ فإن العلم والعمل والزهد إنما يُطلب به ما عند الله من الدرجات العلى والنعيم المقيم، والقربى منه والزلفى لديه...)(24).
ومما يؤكد خطر هذه الشهوة أن جنس بني آدم مولع بحب الرياسة والظهور، كما بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: (إن الإنسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس؛ رأى الواحد يريد نفسه أن تطاع وتعلو بحسب الإمكان، والنفوس مشحونة بحب العلو والرئاسة بحسب إمكانها، فتجده يوالي من يوافقه على هواه، ويعادي من يخالفه في هواه، وإنما معبوده ما يهواه وما يريده)...
إلى أن قال ـ: (فإن كان مطاعاً مسلماً طلب أن يطاع في أغراضه وإن كان فيها ما هو ذنب ومعصية لله، ويكون من أطاعه أحب إليه وأعز عنده ممن أطاع الله وخالف هواه، وهذه شعبة من حال فرعون وسائر المكذبين للرسل.
وإن كان عالماً أو شيخاً أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره، وربما أبغض نظيره حسداً وبغياً..)(25).
إن حب الرئاسة وطلبها لا ينفك عن مفاسد متعددة وشرور متنوعة، وقد أشار ابن رجب إلى بعضها بقوله: (واعلم أن الحرص على الشرف يستلزم ضرراً عظيماً، قبل وقوعه في السعي في أسبابه، وبعد وقوعه بالحرص العظيم الذي يقع فيه صاحب الولاية من الظلم والتكبر، وغير ذلك من المفاسد)(26).
وقال في موضع آخر: (إن حب المال والرئاسة والحرص عليهما يفسد دين المرء حتى لا يبقى منه إلا ما شاء الله... والنفس تحب الرفعة والعلو على أبناء جنسها، ومن هنا نشأ الكبر والحسد)(27).
وذكر ابن القيم ـ رحمه الله ـ بعض مفاسد هذه الشهوة، فقال:
(إن طلاب الرياسة ليسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض، وتعبّد القلوب لهم، وميلها إليهم، ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم، فترتب على هذا المطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والفتنة والحمية للنفس دون حق الله، وتعظيم من حقّره الله، واحتقار من أكرمه الله، ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تُنال إلا به وبأضعافه من المفاسد، والرؤساء في عمىً عن هذا؛ فإذا كُشف الغطاء تبيّن لهم فساد ما كانوا عليه، ولا سيما إذا حُشِروا في صُوَرِ الذرّ يطؤهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتصغيراً كما صغّروا أمر الله وحقروا عباده)(28).
وإذا تقرر ذم حب الرياسة وبيان مفاسدها، فإن حب الإمارة للدعوة إلى الله ـ تعالى ـ يفارق حب الرياسة؛ فإن مقصود هذه الإمارة تعظيم الله ـ تعالى ـ وأمره، وأما مقصود حب الرياسة فهو تعظيم النفوس والسعي في حظوظها، وأئمة العدل وقضاتهم لا يدعون إلى تعظيم نفوسهم البتة، بل إلى تعظيم الله وحده وإفراده بالعبودية، ومنهم من كان لا يريد الولاية إلا للاستعانة بها على الدعوة إلى الله وحده. فمن سأل ربه أن يجعله للمتقين إماماً يقتدي به المتقون، كما اقتدى هو بالمتقين لم يضره ذلك، بل يُحمد عليه؛ لأنه داعٍ إلى الله يحب أن يعبد ويطاع، فهو يحب ما يكون عوناً على ذلك موصلاً إليه (29).
إن على أهل العلم وطلابه أن يحذروا من شهوة حب الرياسة والشهرة، فإنه داء عضال ينبغي المسارعة في علاجه بالتوبة إلى الله ـ تعالى ـ وتزكية النفس ومحاسبتها.
يقول سفيان الثوري ـ رحمه الله ـ: (الرياسة أحب إلى القراء من الذهب الأحمر)(30).
وقد تحدث أبو الفرج ابن الجوزي عن أولئك العلماء المولعين بالرياسات والشهرة فقال: (واليوم صارت الرياسات من كل جانب، وما تتمكن الرياسات حتى يتمكن من القلب: الغفلة، ورؤية الخلق، ونسيان الحق؛ فحينئذ تطلب الرياسة على أهل الدنيا.
ولقد رأيـت مـن الناس عجباً حتى من يتزيا بالعلم، إن رآني أمشي وحدي أنكر عليّ، وإن رآني أزور فـقــيـراً عظّم ذلك، وإن رآني أنبسط بتبسم نقصت من عينه، فقلت: فوا عجباً هذه كانت طريق الـرسـول -صلى الله عليه وسلم- والصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، فصارت أحوال الخلق نواميس لإقـامـــة الجاه، لا جَرَمَ واللهِ! سقطتم من عين الحق، فأسقطكم من عين الخلق...
فـالتفِـتـــوا إخواني إلى إصلاح النيات، وترك التزين للخلق، ولتكن عُمدتكم الاستقامة مع الحق؛ فبذلك صعد السلف وسعدوا)(31).
وفي ختام هـــذه المقالة نسأل الله ـ تعالى ـ أن يرزقنا الهدى والتقوى والعفاف والغنى، وأن يجنبنا شهوات الغي ومضلات الهوى، وبالله التوفيق.
الهوامش:
(1) ذم الهوى، ص 498.
(2) ذم الهوى، ص 501، 502، باختصار يسير، وانظر ص 537.
(3) ذم الهوى، ص 546، 547، باختصار يسير.
(4) روضة المحبين ص 472.
(5) المرجع السابق، ص473.
(6) المرجع السابق 474.
(7) المرجع السابق، 478.
(8) المرجع السابق 479.
(9) المرجع السابق، ص481، 482.
(10) ذم الهوى، ص 483، 484.
(11) أخرجه ابن المبارك في الزهد، ص 189.
(12) سير أعلام النبلاء، 4/579.
(13) أخرجه أبو نعيم في الحلية، 2/152، وانظر: سير أعلام النبلاء، 4/576.
(14) الفوائد، ص 87-89، باختصار.
(15) عدة الصابرين، ص 185، 186، باختصار.
(16) مختصر الفتاوى المصرية، ص 29، وانظر: شجرة المعارف والأحوال، للعز بن عبد السلام، ص 7.
(17) شرح حديث (ما ذئبان جائعان...) ص 7-11، باختصار.
(18) مختصر الفتاوى المصرية، ص 493، وانظر ص 95، وانظر مجموع الفتاوى، 10/189، 190، ومختصر منهاج القاصدين، لأحمد بن قدامة، ص 195.
(19) عدة الصابرين، ص 198، 199، باختصار.
(20) أخرجه أبو نعيم في الحلية، 6/381.
(21) شرح حديث ما (ذئبان جائعان) ص 7، 13، باختصار.
(22) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
(23) شرح حديث (ما ذئبان جائعان)، ص 7، 13، باختصار.
(24) شرح حديث (ما ذئبان جائعان) ص 13، 15، 16، 20، باختصار.
(25) مجموع الفتاوى، 8/218،-باختصار.
(26) شرح حديث (ما ذئبان جائعان)، ص 14.
(27) المرجع السابق، ص 29.
(28) كتاب الروح، ص 433، 434.
(29) انظر: كتاب شرح حديث (ما ذئبان جائعان)، ص 19، وكتاب الروح، ص 432.
(30) كتاب الورع، للإمام أحمد بن حنبل، ص 91.
(31) صيد الخاطر، ص 227، وانظر ص 360، وانظر: أخلاق العلماء للآجري، ص 157.
دراسات في الشريعة والعقيدة
عبودية الشهوات
(2)
سُبُل الدواء
د.عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف
تناول الكاتب ـ وفقه الله ـ فـي الحلقة الأولى الحديث عن الموقف الصحيح تجاه الشهوات ذاكراً أن المسلك العدل إزاءها هــو الـوسـطـيـة بين مـسـلـك أهــل الفجور ومسلك أصحاب الرهبانية، موضحاً أن الإسلام يراعي أحوال الناس ويدرك ما هـم عـلـيـه مــن الـغـرائـــز والشـهـــــوات؛ فهو يبيحها ويعترف بها ولكنه يضبطها ويهذبها، ثم تناول الحديث عن (شهوة النـسـاء). وفـي هـــــــذه الحلقة يتناول علاج هذه الشهوة، ويثنّي بصور أخرى من الشهوات وعلاجها.
علاج شهوة النساء:
بـعـد أن فصّلنا الحديث عن هذه الشهوة نورد علاجها وسبيل النجاة منها، وقد بسط أبو الـفـرج ابــن الجوزي في (ذم الهوى) وابن القيم في (روضة المحبين) الحديث عن العلاج، وأطنبا في وصفه وتشخيصه، وتميّز ابن الـجــوزي بإيراد علاج لكل مرحلة من مراحل هذه الشهوة، فجعل لـلـنظر المحرم علاجاً، وجعل للخلوة بالنساء علاجاً وهكذا. وأما ابن القيم فقد ساق خمسين وسيلة في علاج هذه الشهوة على سبيل الإجمال والعموم.
ومـمــا سطّره يراع أبي الفرج ابن الجوزي في هذا المقام: (واعلم أن أمراض العشق تختلف، فينبغي لذلك أن يختلف علاجها؛ فليس علاج من عنده بداية المرض كعلاج من انتهى به المرض نهايته، وإنـمـــا يُعـالـج مـن هذا المرض من لم يرتقِ إلى غايته؛ فإنه إذا بلغ الغاية أحدث الجنون والذهول، وتلك حالة لا تقبل العلاج)(1).
وقــال أيـضـاً: (فإن تكرار النظر قد نقش صورة المحبوب في القلب نقشاً متمكناً؛ وعلامة ذلك: امـتــلاء القلب بالحبيب؛ فكأنه يراه حالاّ في الصدر، وكأنه يضمه إليه عند النوم ويحادثه في الخلوة، فاعلم أن سبب هذا الطمع في نيل المطلوب، وكفى بالطمع مرضاً، وقلّ أن يقع الفـســــق إلا في المطموع فيه؛ فإن الإنسان لو رأى زوجة الملك فهويها لم يكد قلبـه يتـعـلــق بها؛ لأجل اليأس من مثلها. فأما من طمع في شيء فإن الطمع يحمله على طلبه، ويعذّبه إن لم يدركه..
وعلاج هذا المرض: العزم القوي على البعد عن المحبوب، والقطع الجازم على غض البصر عنه، وهجران الطمع فيه، وتوطين النفس على اليأس منه)(2).
وقـــــال في موضع ثالث: (ومما يُداوى به الباطن أن تفكّر، فتعلم أن محبوبك ليس كما في نفسك، فأعـمــل فكرك في عيوبه تسلُ؛ فإن الآدمي محشوّ بالأنجاس والأقذار، وإنما يرى العاشق معشوقه في حال الكمال، ولا يُصور له الهوى عيباً؛ لأن الحقائق لا تنكشف إلا مع الاعتدال، وسـلـطــان الهوى حاكم جائر يغطي المعايب، فيرى العاشق القبيح من معشوقه حسناً.
ولهذا قال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: (إذا أعجبت أحدَكم امرأةٌ فليذكر مناتنها)(3).
وأما مــا حرّره ابن القيم في سبيل التخلص من شراك هذه الشهوات، فنختار منها بعضها، فمن ذلك قوله:
(التـفـكـر فـي أنه لم يُخلق للهوى، وإنما هُيّئ لأمر عظيم لا يناله إلا بمعصيته للهوى كما قيل:
قد هيؤوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهملِ(4)
(أن يأنف لنفسه مــن ذل طاعة الهوى؛ فإنه ما أطاع أحد هواه قط إلا وجد في نفسه ذلاّ، ولا يـغـتـر بصـولـة أتباع الهوى وكِبرهم؛ فهم أذل الناس بواطنَ، قد جمعوا بين خصلتي الكبر والذل)(5).
(أن يعـلـم أن الـهـــــوى مـــا خالط شيئاً إلا أفسده، فإن وقع في العلم أخرجه إلى البدعة والضلالة وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء، وإن وقع في الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة، وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم وصدّه عن الحق، وإن وقع في الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين حيث يولّي بهواه ويعزل بهواه)(6).
(إن جهاد الهوى إن لم يكن أعـظــم مــن جـهــاد الكفّار فليس بدونه، قال رجل للحسن البصري ـ رحمه الله تعالى ـ: يا أبا سعيد! أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك. وسمعت شيخنا ابن تيمية يقول: (جهاد النفس أصـــــل جهاد الكفّار والمنافقين؛، فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولاً حتى يخرج إليهم)(7).
(إن اتباع الهوى يغلق عن العبد أبواب التوفيق، ويفتح عليه أبواب الخذلان، فتراه يلهج بأن الله لو وفّقه لكان كذا وكذا، وقد سدّ على نفسه طـــــرق الـتـوفـيــق باتباعه هواه. قال الفضيل بن عياض: من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عـنـــه مـــــــوارد التوفيق)(8).
(إن الـتـوحـيــد واتباع الهوى متضادان، فإن الهوى صنم ولكل عبد صنم في قلبه بحسب هواه، وإنما بعث الله رسله بكسر الأصنام وعبادته وحده لا شريك له، وليس مراد الله ـ تعالى ـ كسر الأصنام المجسّدة وترك الأصنام التي في القلب، بل المراد كسرها من القلب أولاً.. وتأمل قول الخليل: ((إذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ)) [الأنبياء: 52]، كيف تجده مطابقاً للتماثيل التي يهواها القلب ويعكف عليها ويعبدها من دون الله ـ تعالى ـ)(9).
(إن لكل عبد بداية ونهاية، فمن كانت بدايته اتباع الهوى، كانت نهايته الذل والصغار والحرمان والبلاء المتبوع بحسب ما اتبع هواه، بل يصير له ذلك في نهايته عذاباً يُعذّب به في قلبه كما قال القائل:
مآرب كانت في الشباب لأهلها عِذاباً فصارت في المشيب عَذاباً
فلو تأملت حال كــــــل ذي حالة سيئة زرية لرأيت بدايته الذهاب مع هواه وإيثاره على عقله، ومن كانت بدايـتـــــه مخالفة هواه وطاعة داعي رشده كانت نهايته العز والشرف والغنى والجاه عند الله وعند الناس. قيل للمهلب ابن أبي صفرة: بِمَ نلت ما نلت؟ قال: بطاعة الحزم وعصيان الهوى. فهذا في بداية الدنيا ونهايتها، وأما الآخرة فقد جعل الله ـ سبحانه ـ الجنة نهاية من خالف هواه، والنار نهاية من اتبع هواه)(10).
وبالجملة: فإنه ما من داء إلا ولــه دواء عَلِمه من علمه، وَجهِله من جهله، والمتعيّن على من ابتلي بشيء من هذه الشهوات أن يـبـــادر إلـى أســبــاب النجاة ووسائلها.. بالعزيمة الصادقة، والصبر والمصابرة، وعلو الهمة والاشتغال بمعالي الأمور والابتعاد عن سفاسفها، والمجاهدة في ذات الله ـ تعالى ـ، ونهي النفس عن الهوى وإصلاح الخواطر والإرادات، وصحبة الصالحين، ودوام التضرع إلى الله ـ تعالى ـ والانكسار بين يديه سبحانه.
شهوة المال:
اسـتـولـى عـلـى أفئدة كثير من الناس الولع بالمال، فأُشربوا حبه والتعلق به، فاستعبدهم الدرهم والديـنــــار، وصار هِجّيراهم ومقصودهم وجلّ حديثهم واهتمامهم، فإن أحبوا فلا يحبون إلا لأجل المال، وإن أبغضوا فلا يبغضون إلا لأجل المال: إن أُعطوا رضوا، وإن لم يُعطَوْا إذا هم يسخطون.
ولقد ذمّ الله ـ تعالى ـ الدنيا في كتابه في غير موضع، كقوله ـ تعالى ـ: ((وَمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا إلاَّ مَتَاعُ الغُرُورِ)) [الحديد: 20] وقوله ـ سبحانه ـ: ((اعْلَمُوا أَنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ)) [الحديد: 20].
وأما الأحاديث في ذم الدنيا وفضل الزهد فكثيرة جداً؛ منها حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قـــــــال: جلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المنبر، وجلسنا حوله، فقال: (إنّ مما أخاف عليكم من بعدي ما يُفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها) متفق عليه.
وعن أبي هريرة -رضي الله عــنـــه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخمـيـصــــة، إن أعطي رضي، وإن لم يُعطَ لم يرضَ) أخرجه البخاري.
وعن كعب بن عيا ض -رضي الله عنه- قا ل: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يـقــــــول: (إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال) أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
وعن كـعــب بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله: (ما ذئبان جائعان أُرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه) أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
وقد ورد عــــــن الحسن البصري ـ رحمه الله ـ: أنه قال: إياكم وما شغل من الدنيا؛ فإن الدنيا كثيرة الأشغال، لا يفتح رجل على نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب)(11).
وكان يقول أيـضـــــاً: (أهينوا الدنيا فو الله لأهنأ ما تكون إذا أهنتها)(12). وكان الحسن يحلف بالله ما أعز أحدٌ الدرهمَ إلا أذله الله)(13).
ولابن القيم ـ رحـمـــــه الله ـ كـلام نفـيس في الترغـيب بالزهـد في الدنيا، والإقبال على الآخـرة، نـورد منـه ما يلي:
(لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين:
نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها، وألم المزاحمة عليها والحرص عليها، وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد، وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحـسـرة والأسف؛ فطالبها لا ينفك من همّ قبل حصولها، وهمّ في حال الظفر بها، وغم وحزن بعد فواتها؛ فهذا أحد النظرين.
النظر الثاني: النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد، ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات، والتفاوت الذي بينه وبين ما ههنا؛ فهي كما قال الله ـ سبحانه ـ: ((وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى)) [الأعلى: 17] فهي خيرات كاملة دائمة، وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة).
ـ إلى أن قال ـ: (وقد توعّـــد الله ـ سبحانه ـ أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها وغفل عن آياته ولم يرجُ لقاءه فقال: ((إنَّ الَذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هـُــــمْ عَــــنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ(7)أُوْلَئِكَ مَاًوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)) [يونس: 7، 8] وعيّر ـ سبحانه ـ من رضي بالدنيا من المؤمنين فقال: ((يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَـبـِـيــلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إلاَّ قَلِيلٌ)) [التوبة: 38] وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة.
ويكفي في الزهد في الدنيا قوله ـ تعالى ـ: ((أَفَرَأَيْتَ إن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ (205) ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ (206) مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ)) [الشعراء: 205-207])(14).
وجاء في كتاب: (عدة الصابرين) لابن القيم ما يلي: (جميع الأمم المكذبة لأنبيائهم إنما حملهم على كفرهم وهلاكهم حب الدنيا، فإن الرسل لما نهوهم عن الشرك والمعاصي التي كانوا يكسبون بها الدنيا حملهم حبها على مخالفتهم وتكذيبهم؛ فكل خطيئة في العالم أصلها حب الدنيا... فحب الدنيا والرياسة هو الذي عمر النار بأهلها، والزهد في الدنيا والرياسة هو الذي عمر الجنة بأهلها، والسكر بحب الدنيا أعظم من السكر بشرب الخمر بكثير، وصاحب هذا السكر لا يفيق منه إلا في ظلمة اللحد... والدنيا تسحر العقول أعظم سحر.
قال مالك بن دينار: (اتقوا السحّارة، اتقوا السحّارة؛ فإنها تسحر قلوب العلماء).
وأقل ما في حبها أنه يلهي عن حب الله وذكره، ومن ألهاه ماله عن ذكر الله ـ تعالى ـ فهو من الخاسرين، وإذا لها القلب عن ذكر الله سكنه الشيطان وصرفه حيث أراد)(15).
وقد بالغ العلماء في التحذير من الاستمتاع بالدنيا والانكباب عليها، حتى جعلوا مجرد النظـر إلى الدنيـا ـ إن كان على سبيل استحسانها والركون إليها ـ مذموماً، كما وضّحه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله:
(النظر إلى الأشجار والخيل والبهائم إذا كان على وجه استحسان الدنيا والرياسة والمال فهو مذموم؛ لقول الله ـ تعالى ـ: ((وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى)) [طه: 131].
وأما إذا كان على وجه لا ينقص الدين، وإنما فيه راحة النفس فقط، كالنظر إلى الأزهار، فهذا من الباطل الذي يستعان به على الحق)(16).
إن الحرص على المال يكون على وجهين؛ كما قرر الحافظ ابن رجب بقوله:
(أحدهما: شدة محبة المال مع طلبه من وجوه مباحة، والمبالغة في طلبه والجد في تحصيله واكتسابه من وجوهه مع الجهد والمشقة...
ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع العمر الشريف فيما لا قيمة له ـ وقد يُمكّن صاحبه فيه اكتساب الدرجات العلى، والنعيم المقيم، فضيعه بالحرص في طلب رزق مضمون مقسوم لا يأتي منه إلا ما قُدّر وقُسـم؛ ثم لا ينتفـع به بل يتركـه لغيره ويرتحل عنه فيبقى حسابه عليه ونفعـه لغيـره، فيجمـع لمن لا يحمـده، ويقـدم على من لا يعـذره لكفـاه بـذلك ذماً للحرص؛ فالحريص يضيع زمانه الشريف، ويخاطر بنفسه في الأسفار وركوب الأخطار لجمع مال ينتفع به غيره.
النوع الثاني: من الحرص على المال أن يزيد على ما سبق ذكره في النوع الأول، حتى يطلب المال من الوجوه المحرمة، ويمنع الحقوق الواجبة، فهذا من الشح المذموم، قال الله ـ تعالى ـ: ((وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ)) [التغابن: 16].
وفي صحيح مسلم عن جابر ـ رضي الله عنه ـ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (اتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم: حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم)(17).
وإنما يصير حب المال مذموماً إذا كان سبباً في ارتكاب المعاصي أو ترك الواجبات، يقول شيخ الإسلام في هذا الصدد: (حب المال والشرف يفسد الدين، والذي يعاقب عليه الشخص هو الحب الذي يدعو إلى المعاصي مثل الظلم والكذب والفواحش، ولا ريب أن فرط الحرص على المال والرياسة يوجب ذلك، أما مجرد حب القلب إذا كان الإنسان يفعل ما أمر الله به ويترك ما نهى عنه، ويخاف مقام ربه، وينهى النفس عن الهوى؛ فإن الله ـ تعالى ـ لا يعاقب على مثل هذا إذا لم يكن معه عمل.
وجمع المال إذا قام فيه بالواجبات ولم يكتسبه من الحرام لا يعاقب عليه، لكن إخراج الفضل والاقتصار على الكفاية أفضل وأسلم، وأفرغ للقلب وأجمع للهم، وأنفع للدنيا والآخرة، وقد قال: (من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله، وجعل فقره في عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي راغمة)(18).
وينبغي التوسط إزاء المال بين الشره والانهماك عليه، وبين تركه والإعراض عنه؛ كما في حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فخطب الناس فقال: (لا والله ما أخشى عليكم إلا ما يُخرِج الله لكم من زهرة الدنيا)، فقال رجل: يا رسول الله! أوَ يأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم قال: كيف قلتَ؟ قال: يا رسول الله! أوَ يأتي الخير بالشر؟ فقال رسول الله: (إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً، أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس فثلطت وبالت، ثم اجترّت فعادت فأكلت، فمن أخذ مالاً بحقه بورك له فيه، ومن أخذ مالاً بغير حقه؛ فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع) متفق عليه.
وقد شرح ابن القيم هذا الحديث وبيّن المسلك الوسط تجاه المال فقال: (قوله: (إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يلم)) هذا من أحسن التمثيل المتضمن للتحذير من الدنيا والانهماك عليها والمسرة فيها، وذلك أن الماشية يروقها نبت الربيع فتأكل منه بأعينها فربما هلكت حبطاً، (والحبط انتفاخ بطن الدابة من الامتلاء أو من المرض)، فكذلك الشرِه في المال يقتله شرهه وحرصه، فإن لم يقتله قارب أن يقتله، وهو قوله: (أو يلم)، وكثير من أرباب الأموال إنما قتلهم أموالهم؛ فإنهم شرهوا في جمعها واحتاج إليها غيرهم، فلم يصلوا إليها إلا بقتلهم أو ما يقاربه من إذلالهم وقهرهم.
وقوله: (إلا آكلة الخضر) هذا تمثيل لمن أخذ من الدنيا حاجته، مثّله بالشاة الآكلة من الخضر بقدر حاجتها، أكلت حتى امتلأت خاصرتاها...
وفي قوله: (استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت) ثلاث فوائد: أحدها أنها لما أخذت حاجتها من المرعى تركته وبركت مستقبلة الشمس لتستمرئ بذلك ما أكلته. الثانية: أنها أعرضت عما يضرها من الشره في المرعى وأقبلت على ما ينفعها من استقبال الشمس التي يحصل لها بحرارتها إنضاح ما أكلته وإخراجه. الثالثة: أنها استفرغت بالبول والثلط ما جمعته من المرعى في بطنها فاستراحت بإخراجه، ولو بقي فيها لقتلها، فكذلك جامع المال مصلحته أن يفعل به كما فعلت هذه الشاة...
وفي هذا الحديث إشارة إلى الاعتدال والتوسط بين الشره في المرعى القاتل بكثرته، وبين الإعراض عنه وتركه بالكلية فتهلك جوعاً. وتضمّن الخبر أيضاً إرشاد المكثر من المال إلى ما يحفظ عليه قوته وصحته في بدنه وقلبه وهو الإخراج منه وإنفاقه ولا يحبسه فيضره حبسه)(19).
وإذا تقررت هذه الوسطية تجاه المال فإن على العلماء والدعاة خصوصاً أن يُعْنَوْا بتحقيق الكفاف والاستغناء عن الناس كما يُعْنَوْا بالزهد والتقلل من الدنيا؛ فإن استغناء العلماء عن الناس عموماً والحكام خصوصاً من أعظم الأسباب في حفظ مكانة العلماء وعظم شأنهم.
يقول سفيان الثوري ـ رحمه الله ـ: (لأن أخلّف عشرة آلاف درهم أحاسب عليها أحب إليّ من أن أحتاج إلى الناس... ولولا هذه الدراهم لتمندل بنا هؤلاء الملوك)(20).
يقول ابن الجوزي حاثاً على الاستغناء عن الناس: (ليس في الدنيا أنفع للعلماء من جمع المال للاستغناء عن الناس، فإنه إذا ضم إلى العلم حيز الكمال، وإن جمهور العلماء شغلهم العلم عن الكسب، فاحتاجوا إلى ما لا بد منه، وقلّ الصبر فدخلوا مداخل شانتهم وإن تأوّلوا فيها...
ولقد رأينا جماعة من المتصوفة والعلماء يغْشون الولاة لأجل نيل ما في أيديهم؛ فمنهم من يداهن ويرائي، ومنهم من يمدح بما لا يجوز، ومنهم من يسكت عن منكرات إلى غير ذلك من المداهنات، وسببها الفقر، فعلمنا أن كمال العز وبُعد الرياء إنما يكون في البعد عن العمال الظّلَمَة، ولم نرَ من صح له هذا إلا في أحد رجلين:
أما من كان له مال كسعيد بن المسيب كان يتجر في الزيت وغيره، وسفيان الثوري كانت له بضائع، وابن المبارك. وأما من كان شديد الصبر قنوعاً بما رزق ـ وإن لم يكفه ـ كبشر الحافي وأحمد بن حنبل؛ ومتى لم يجد الإنسان كصبر هذين، ولا كمال أولئك، فالظاهر تقلبه في المحن والآفات، وربما تلف دينه.
فعليك يا طالب العلم بالاجتهاد في جمع المال للغنى عن الناس؛ فإنه يجمع لك دينك، فما رأينا في الأغلب منافقاً في التدين والتزهد والتخشع، ولا آفة طرأت على عالم إلا بحبّ الدنيا، وغالب ذلك الفقر، فإن كان من له ما يكفيه ثم يطلب بتلك المخالطة الزيادة فذلك معدود في أهل الشّرَهِ، خارج عن حيّز العلماء)(21).
* والمقصود أن على العبد أن يقنع بالكفاف من هذا المال، مما يحتاجه في مطعمه ومشربه ومسكنه وملبسه ونحو ذلك، وأن يطلب ذلك من الله ـ تعالى ـ وحده ويرغب إليه فيه، وأن لا يكون سائلاً للمال بلسانه ـ إلا لضرورة ـ أو مستشرفاً إليه بقلبه.
وأما ما لا يحتاج إليه العبد فلا ينبغي له الاشتغال به؛ لأن ذلك يؤول إلى تعلق القلب بالمال واستعباده له، كما يفوت عمره في تحصيل رزق مقسوم، وقد يحمله الحرص على المال على اكتسابه بالحرام ومنع الحقوق الواجبة.
شهوة الرياسة:
شهوة حب الرياسة والمنصب إحدى الشهوات التي استعبدت كثيراً من الناس وأحكمت على أفئدتهم، فصارت الولايات والمناصب وما يتبعها من الشهرة والظهور مقصودهم ومرادهم.
وقد سبق إيراد حديث كعب بن مالك ـ رضي الله عنه ـ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (ما ذئبان جائعان أُرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه)(22).
يقول الحافظ ابن رجب ـ رحمه الله ـ في شرح هذا الحديث: (فأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن حرص المرء على المال والشرف إفساد لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم، بل إما أن يكون مساوياً وإما أكثر، يشير أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل، كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا القليل. فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا).
ـ إلى أن قال ـ: (وأما حرص المرء على الشرف فهو أشد إهلاكاً من الحرص على المال؛ فإن طلب شرف الدنيا والرفعة فيها، والرياسة على الناس والعلو في الأرض أضر على العبد من طلب المال، وضرره أعظم والزهد فيه أصعب؛ فإن المال يبذل في طلب الرياسة والشرف)(23).
ثم ذكر ـ رحمه الله ـ أقسام الحرص على الشرف فقال: (والحرص على الشرف قسمان:
أحدها: طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال، وهذا خطر جداً، وهو في الغالب يمنع خير الآخرة وشرفها وكرامتها وعزها. قال الله ـ تعالى ـ: ((تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُواً فِي الأَرْضِ وَلا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)) [القصص: 83]، وقلّ من يحرص على رياسة الدنيا بطلب الولايات فيوفق بل يوكَل إلى نفسه).
إلى أن قال ـ: (ومن دقيق آفات حب الشرف: طلب الولايات والحرص عليها، وهو باب غامض لا يعرفه إلا العلماء بالله العارفون به المحبون له....
واعلم أن حب الشرف بالحرص على نفوذ الأمر والنهي، وتدبير أمر الناس إذا قُصِدَ بذلك مجرد علو المنزلة على الخلق، والتعاظم عليهم، وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس وافتقارهم إليه، وذلهم له في طلب حوائجهم منه؛ فهذا نفسه مزاحمة لربوبية الله وإلهيته.
القسم الثاني: طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية كالعلم والعمل والزهد؛ فهذا أفحش من الأول، وأقبح وأشد فساداً وخطراً؛ فإن العلم والعمل والزهد إنما يُطلب به ما عند الله من الدرجات العلى والنعيم المقيم، والقربى منه والزلفى لديه...)(24).
ومما يؤكد خطر هذه الشهوة أن جنس بني آدم مولع بحب الرياسة والظهور، كما بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: (إن الإنسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس؛ رأى الواحد يريد نفسه أن تطاع وتعلو بحسب الإمكان، والنفوس مشحونة بحب العلو والرئاسة بحسب إمكانها، فتجده يوالي من يوافقه على هواه، ويعادي من يخالفه في هواه، وإنما معبوده ما يهواه وما يريده)...
إلى أن قال ـ: (فإن كان مطاعاً مسلماً طلب أن يطاع في أغراضه وإن كان فيها ما هو ذنب ومعصية لله، ويكون من أطاعه أحب إليه وأعز عنده ممن أطاع الله وخالف هواه، وهذه شعبة من حال فرعون وسائر المكذبين للرسل.
وإن كان عالماً أو شيخاً أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره، وربما أبغض نظيره حسداً وبغياً..)(25).
إن حب الرئاسة وطلبها لا ينفك عن مفاسد متعددة وشرور متنوعة، وقد أشار ابن رجب إلى بعضها بقوله: (واعلم أن الحرص على الشرف يستلزم ضرراً عظيماً، قبل وقوعه في السعي في أسبابه، وبعد وقوعه بالحرص العظيم الذي يقع فيه صاحب الولاية من الظلم والتكبر، وغير ذلك من المفاسد)(26).
وقال في موضع آخر: (إن حب المال والرئاسة والحرص عليهما يفسد دين المرء حتى لا يبقى منه إلا ما شاء الله... والنفس تحب الرفعة والعلو على أبناء جنسها، ومن هنا نشأ الكبر والحسد)(27).
وذكر ابن القيم ـ رحمه الله ـ بعض مفاسد هذه الشهوة، فقال:
(إن طلاب الرياسة ليسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض، وتعبّد القلوب لهم، وميلها إليهم، ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم، فترتب على هذا المطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والفتنة والحمية للنفس دون حق الله، وتعظيم من حقّره الله، واحتقار من أكرمه الله، ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تُنال إلا به وبأضعافه من المفاسد، والرؤساء في عمىً عن هذا؛ فإذا كُشف الغطاء تبيّن لهم فساد ما كانوا عليه، ولا سيما إذا حُشِروا في صُوَرِ الذرّ يطؤهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتصغيراً كما صغّروا أمر الله وحقروا عباده)(28).
وإذا تقرر ذم حب الرياسة وبيان مفاسدها، فإن حب الإمارة للدعوة إلى الله ـ تعالى ـ يفارق حب الرياسة؛ فإن مقصود هذه الإمارة تعظيم الله ـ تعالى ـ وأمره، وأما مقصود حب الرياسة فهو تعظيم النفوس والسعي في حظوظها، وأئمة العدل وقضاتهم لا يدعون إلى تعظيم نفوسهم البتة، بل إلى تعظيم الله وحده وإفراده بالعبودية، ومنهم من كان لا يريد الولاية إلا للاستعانة بها على الدعوة إلى الله وحده. فمن سأل ربه أن يجعله للمتقين إماماً يقتدي به المتقون، كما اقتدى هو بالمتقين لم يضره ذلك، بل يُحمد عليه؛ لأنه داعٍ إلى الله يحب أن يعبد ويطاع، فهو يحب ما يكون عوناً على ذلك موصلاً إليه (29).
إن على أهل العلم وطلابه أن يحذروا من شهوة حب الرياسة والشهرة، فإنه داء عضال ينبغي المسارعة في علاجه بالتوبة إلى الله ـ تعالى ـ وتزكية النفس ومحاسبتها.
يقول سفيان الثوري ـ رحمه الله ـ: (الرياسة أحب إلى القراء من الذهب الأحمر)(30).
وقد تحدث أبو الفرج ابن الجوزي عن أولئك العلماء المولعين بالرياسات والشهرة فقال: (واليوم صارت الرياسات من كل جانب، وما تتمكن الرياسات حتى يتمكن من القلب: الغفلة، ورؤية الخلق، ونسيان الحق؛ فحينئذ تطلب الرياسة على أهل الدنيا.
ولقد رأيـت مـن الناس عجباً حتى من يتزيا بالعلم، إن رآني أمشي وحدي أنكر عليّ، وإن رآني أزور فـقــيـراً عظّم ذلك، وإن رآني أنبسط بتبسم نقصت من عينه، فقلت: فوا عجباً هذه كانت طريق الـرسـول -صلى الله عليه وسلم- والصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، فصارت أحوال الخلق نواميس لإقـامـــة الجاه، لا جَرَمَ واللهِ! سقطتم من عين الحق، فأسقطكم من عين الخلق...
فـالتفِـتـــوا إخواني إلى إصلاح النيات، وترك التزين للخلق، ولتكن عُمدتكم الاستقامة مع الحق؛ فبذلك صعد السلف وسعدوا)(31).
وفي ختام هـــذه المقالة نسأل الله ـ تعالى ـ أن يرزقنا الهدى والتقوى والعفاف والغنى، وأن يجنبنا شهوات الغي ومضلات الهوى، وبالله التوفيق.
الهوامش:
(1) ذم الهوى، ص 498.
(2) ذم الهوى، ص 501، 502، باختصار يسير، وانظر ص 537.
(3) ذم الهوى، ص 546، 547، باختصار يسير.
(4) روضة المحبين ص 472.
(5) المرجع السابق، ص473.
(6) المرجع السابق 474.
(7) المرجع السابق، 478.
(8) المرجع السابق 479.
(9) المرجع السابق، ص481، 482.
(10) ذم الهوى، ص 483، 484.
(11) أخرجه ابن المبارك في الزهد، ص 189.
(12) سير أعلام النبلاء، 4/579.
(13) أخرجه أبو نعيم في الحلية، 2/152، وانظر: سير أعلام النبلاء، 4/576.
(14) الفوائد، ص 87-89، باختصار.
(15) عدة الصابرين، ص 185، 186، باختصار.
(16) مختصر الفتاوى المصرية، ص 29، وانظر: شجرة المعارف والأحوال، للعز بن عبد السلام، ص 7.
(17) شرح حديث (ما ذئبان جائعان...) ص 7-11، باختصار.
(18) مختصر الفتاوى المصرية، ص 493، وانظر ص 95، وانظر مجموع الفتاوى، 10/189، 190، ومختصر منهاج القاصدين، لأحمد بن قدامة، ص 195.
(19) عدة الصابرين، ص 198، 199، باختصار.
(20) أخرجه أبو نعيم في الحلية، 6/381.
(21) شرح حديث ما (ذئبان جائعان) ص 7، 13، باختصار.
(22) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
(23) شرح حديث (ما ذئبان جائعان)، ص 7، 13، باختصار.
(24) شرح حديث (ما ذئبان جائعان) ص 13، 15، 16، 20، باختصار.
(25) مجموع الفتاوى، 8/218،-باختصار.
(26) شرح حديث (ما ذئبان جائعان)، ص 14.
(27) المرجع السابق، ص 29.
(28) كتاب الروح، ص 433، 434.
(29) انظر: كتاب شرح حديث (ما ذئبان جائعان)، ص 19، وكتاب الروح، ص 432.
(30) كتاب الورع، للإمام أحمد بن حنبل، ص 91.
(31) صيد الخاطر، ص 227، وانظر ص 360، وانظر: أخلاق العلماء للآجري، ص 157.
4
عبودية الشهوات
(2)
سُبُل الدواء
د.عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف
تناول الكاتب ـ وفقه الله ـ فـي الحلقة الأولى الحديث عن الموقف الصحيح تجاه الشهوات ذاكراً أن المسلك العدل إزاءها هــو الـوسـطـيـة بين مـسـلـك أهــل الفجور ومسلك أصحاب الرهبانية، موضحاً أن الإسلام يراعي أحوال الناس ويدرك ما هـم عـلـيـه مــن الـغـرائـــز والشـهـــــوات؛ فهو يبيحها ويعترف بها ولكنه يضبطها ويهذبها، ثم تناول الحديث عن (شهوة النـسـاء). وفـي هـــــــذه الحلقة يتناول علاج هذه الشهوة، ويثنّي بصور أخرى من الشهوات وعلاجها.
علاج شهوة النساء:
بـعـد أن فصّلنا الحديث عن هذه الشهوة نورد علاجها وسبيل النجاة منها، وقد بسط أبو الـفـرج ابــن الجوزي في (ذم الهوى) وابن القيم في (روضة المحبين) الحديث عن العلاج، وأطنبا في وصفه وتشخيصه، وتميّز ابن الـجــوزي بإيراد علاج لكل مرحلة من مراحل هذه الشهوة، فجعل لـلـنظر المحرم علاجاً، وجعل للخلوة بالنساء علاجاً وهكذا. وأما ابن القيم فقد ساق خمسين وسيلة في علاج هذه الشهوة على سبيل الإجمال والعموم.
ومـمــا سطّره يراع أبي الفرج ابن الجوزي في هذا المقام: (واعلم أن أمراض العشق تختلف، فينبغي لذلك أن يختلف علاجها؛ فليس علاج من عنده بداية المرض كعلاج من انتهى به المرض نهايته، وإنـمـــا يُعـالـج مـن هذا المرض من لم يرتقِ إلى غايته؛ فإنه إذا بلغ الغاية أحدث الجنون والذهول، وتلك حالة لا تقبل العلاج)(1).
وقــال أيـضـاً: (فإن تكرار النظر قد نقش صورة المحبوب في القلب نقشاً متمكناً؛ وعلامة ذلك: امـتــلاء القلب بالحبيب؛ فكأنه يراه حالاّ في الصدر، وكأنه يضمه إليه عند النوم ويحادثه في الخلوة، فاعلم أن سبب هذا الطمع في نيل المطلوب، وكفى بالطمع مرضاً، وقلّ أن يقع الفـســــق إلا في المطموع فيه؛ فإن الإنسان لو رأى زوجة الملك فهويها لم يكد قلبـه يتـعـلــق بها؛ لأجل اليأس من مثلها. فأما من طمع في شيء فإن الطمع يحمله على طلبه، ويعذّبه إن لم يدركه..
وعلاج هذا المرض: العزم القوي على البعد عن المحبوب، والقطع الجازم على غض البصر عنه، وهجران الطمع فيه، وتوطين النفس على اليأس منه)(2).
وقـــــال في موضع ثالث: (ومما يُداوى به الباطن أن تفكّر، فتعلم أن محبوبك ليس كما في نفسك، فأعـمــل فكرك في عيوبه تسلُ؛ فإن الآدمي محشوّ بالأنجاس والأقذار، وإنما يرى العاشق معشوقه في حال الكمال، ولا يُصور له الهوى عيباً؛ لأن الحقائق لا تنكشف إلا مع الاعتدال، وسـلـطــان الهوى حاكم جائر يغطي المعايب، فيرى العاشق القبيح من معشوقه حسناً.
ولهذا قال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: (إذا أعجبت أحدَكم امرأةٌ فليذكر مناتنها)(3).
وأما مــا حرّره ابن القيم في سبيل التخلص من شراك هذه الشهوات، فنختار منها بعضها، فمن ذلك قوله:
(التـفـكـر فـي أنه لم يُخلق للهوى، وإنما هُيّئ لأمر عظيم لا يناله إلا بمعصيته للهوى كما قيل:
قد هيؤوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهملِ(4)
(أن يأنف لنفسه مــن ذل طاعة الهوى؛ فإنه ما أطاع أحد هواه قط إلا وجد في نفسه ذلاّ، ولا يـغـتـر بصـولـة أتباع الهوى وكِبرهم؛ فهم أذل الناس بواطنَ، قد جمعوا بين خصلتي الكبر والذل)(5).
(أن يعـلـم أن الـهـــــوى مـــا خالط شيئاً إلا أفسده، فإن وقع في العلم أخرجه إلى البدعة والضلالة وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء، وإن وقع في الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة، وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم وصدّه عن الحق، وإن وقع في الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين حيث يولّي بهواه ويعزل بهواه)(6).
(إن جهاد الهوى إن لم يكن أعـظــم مــن جـهــاد الكفّار فليس بدونه، قال رجل للحسن البصري ـ رحمه الله تعالى ـ: يا أبا سعيد! أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك. وسمعت شيخنا ابن تيمية يقول: (جهاد النفس أصـــــل جهاد الكفّار والمنافقين؛، فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولاً حتى يخرج إليهم)(7).
(إن اتباع الهوى يغلق عن العبد أبواب التوفيق، ويفتح عليه أبواب الخذلان، فتراه يلهج بأن الله لو وفّقه لكان كذا وكذا، وقد سدّ على نفسه طـــــرق الـتـوفـيــق باتباعه هواه. قال الفضيل بن عياض: من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عـنـــه مـــــــوارد التوفيق)(8).
(إن الـتـوحـيــد واتباع الهوى متضادان، فإن الهوى صنم ولكل عبد صنم في قلبه بحسب هواه، وإنما بعث الله رسله بكسر الأصنام وعبادته وحده لا شريك له، وليس مراد الله ـ تعالى ـ كسر الأصنام المجسّدة وترك الأصنام التي في القلب، بل المراد كسرها من القلب أولاً.. وتأمل قول الخليل: ((إذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ)) [الأنبياء: 52]، كيف تجده مطابقاً للتماثيل التي يهواها القلب ويعكف عليها ويعبدها من دون الله ـ تعالى ـ)(9).
(إن لكل عبد بداية ونهاية، فمن كانت بدايته اتباع الهوى، كانت نهايته الذل والصغار والحرمان والبلاء المتبوع بحسب ما اتبع هواه، بل يصير له ذلك في نهايته عذاباً يُعذّب به في قلبه كما قال القائل:
مآرب كانت في الشباب لأهلها عِذاباً فصارت في المشيب عَذاباً
فلو تأملت حال كــــــل ذي حالة سيئة زرية لرأيت بدايته الذهاب مع هواه وإيثاره على عقله، ومن كانت بدايـتـــــه مخالفة هواه وطاعة داعي رشده كانت نهايته العز والشرف والغنى والجاه عند الله وعند الناس. قيل للمهلب ابن أبي صفرة: بِمَ نلت ما نلت؟ قال: بطاعة الحزم وعصيان الهوى. فهذا في بداية الدنيا ونهايتها، وأما الآخرة فقد جعل الله ـ سبحانه ـ الجنة نهاية من خالف هواه، والنار نهاية من اتبع هواه)(10).
وبالجملة: فإنه ما من داء إلا ولــه دواء عَلِمه من علمه، وَجهِله من جهله، والمتعيّن على من ابتلي بشيء من هذه الشهوات أن يـبـــادر إلـى أســبــاب النجاة ووسائلها.. بالعزيمة الصادقة، والصبر والمصابرة، وعلو الهمة والاشتغال بمعالي الأمور والابتعاد عن سفاسفها، والمجاهدة في ذات الله ـ تعالى ـ، ونهي النفس عن الهوى وإصلاح الخواطر والإرادات، وصحبة الصالحين، ودوام التضرع إلى الله ـ تعالى ـ والانكسار بين يديه سبحانه.
شهوة المال:
اسـتـولـى عـلـى أفئدة كثير من الناس الولع بالمال، فأُشربوا حبه والتعلق به، فاستعبدهم الدرهم والديـنــــار، وصار هِجّيراهم ومقصودهم وجلّ حديثهم واهتمامهم، فإن أحبوا فلا يحبون إلا لأجل المال، وإن أبغضوا فلا يبغضون إلا لأجل المال: إن أُعطوا رضوا، وإن لم يُعطَوْا إذا هم يسخطون.
ولقد ذمّ الله ـ تعالى ـ الدنيا في كتابه في غير موضع، كقوله ـ تعالى ـ: ((وَمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا إلاَّ مَتَاعُ الغُرُورِ)) [الحديد: 20] وقوله ـ سبحانه ـ: ((اعْلَمُوا أَنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ)) [الحديد: 20].
وأما الأحاديث في ذم الدنيا وفضل الزهد فكثيرة جداً؛ منها حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قـــــــال: جلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المنبر، وجلسنا حوله، فقال: (إنّ مما أخاف عليكم من بعدي ما يُفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها) متفق عليه.
وعن أبي هريرة -رضي الله عــنـــه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخمـيـصــــة، إن أعطي رضي، وإن لم يُعطَ لم يرضَ) أخرجه البخاري.
وعن كعب بن عيا ض -رضي الله عنه- قا ل: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يـقــــــول: (إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال) أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
وعن كـعــب بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله: (ما ذئبان جائعان أُرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه) أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
وقد ورد عــــــن الحسن البصري ـ رحمه الله ـ: أنه قال: إياكم وما شغل من الدنيا؛ فإن الدنيا كثيرة الأشغال، لا يفتح رجل على نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب)(11).
وكان يقول أيـضـــــاً: (أهينوا الدنيا فو الله لأهنأ ما تكون إذا أهنتها)(12). وكان الحسن يحلف بالله ما أعز أحدٌ الدرهمَ إلا أذله الله)(13).
ولابن القيم ـ رحـمـــــه الله ـ كـلام نفـيس في الترغـيب بالزهـد في الدنيا، والإقبال على الآخـرة، نـورد منـه ما يلي:
(لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين:
نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها، وألم المزاحمة عليها والحرص عليها، وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد، وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحـسـرة والأسف؛ فطالبها لا ينفك من همّ قبل حصولها، وهمّ في حال الظفر بها، وغم وحزن بعد فواتها؛ فهذا أحد النظرين.
النظر الثاني: النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد، ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات، والتفاوت الذي بينه وبين ما ههنا؛ فهي كما قال الله ـ سبحانه ـ: ((وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى)) [الأعلى: 17] فهي خيرات كاملة دائمة، وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة).
ـ إلى أن قال ـ: (وقد توعّـــد الله ـ سبحانه ـ أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها وغفل عن آياته ولم يرجُ لقاءه فقال: ((إنَّ الَذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هـُــــمْ عَــــنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ(7)أُوْلَئِكَ مَاًوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)) [يونس: 7، 8] وعيّر ـ سبحانه ـ من رضي بالدنيا من المؤمنين فقال: ((يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَـبـِـيــلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إلاَّ قَلِيلٌ)) [التوبة: 38] وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة.
ويكفي في الزهد في الدنيا قوله ـ تعالى ـ: ((أَفَرَأَيْتَ إن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ (205) ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ (206) مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ)) [الشعراء: 205-207])(14).
وجاء في كتاب: (عدة الصابرين) لابن القيم ما يلي: (جميع الأمم المكذبة لأنبيائهم إنما حملهم على كفرهم وهلاكهم حب الدنيا، فإن الرسل لما نهوهم عن الشرك والمعاصي التي كانوا يكسبون بها الدنيا حملهم حبها على مخالفتهم وتكذيبهم؛ فكل خطيئة في العالم أصلها حب الدنيا... فحب الدنيا والرياسة هو الذي عمر النار بأهلها، والزهد في الدنيا والرياسة هو الذي عمر الجنة بأهلها، والسكر بحب الدنيا أعظم من السكر بشرب الخمر بكثير، وصاحب هذا السكر لا يفيق منه إلا في ظلمة اللحد... والدنيا تسحر العقول أعظم سحر.
قال مالك بن دينار: (اتقوا السحّارة، اتقوا السحّارة؛ فإنها تسحر قلوب العلماء).
وأقل ما في حبها أنه يلهي عن حب الله وذكره، ومن ألهاه ماله عن ذكر الله ـ تعالى ـ فهو من الخاسرين، وإذا لها القلب عن ذكر الله سكنه الشيطان وصرفه حيث أراد)(15).
وقد بالغ العلماء في التحذير من الاستمتاع بالدنيا والانكباب عليها، حتى جعلوا مجرد النظـر إلى الدنيـا ـ إن كان على سبيل استحسانها والركون إليها ـ مذموماً، كما وضّحه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله:
(النظر إلى الأشجار والخيل والبهائم إذا كان على وجه استحسان الدنيا والرياسة والمال فهو مذموم؛ لقول الله ـ تعالى ـ: ((وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى)) [طه: 131].
وأما إذا كان على وجه لا ينقص الدين، وإنما فيه راحة النفس فقط، كالنظر إلى الأزهار، فهذا من الباطل الذي يستعان به على الحق)(16).
إن الحرص على المال يكون على وجهين؛ كما قرر الحافظ ابن رجب بقوله:
(أحدهما: شدة محبة المال مع طلبه من وجوه مباحة، والمبالغة في طلبه والجد في تحصيله واكتسابه من وجوهه مع الجهد والمشقة...
ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع العمر الشريف فيما لا قيمة له ـ وقد يُمكّن صاحبه فيه اكتساب الدرجات العلى، والنعيم المقيم، فضيعه بالحرص في طلب رزق مضمون مقسوم لا يأتي منه إلا ما قُدّر وقُسـم؛ ثم لا ينتفـع به بل يتركـه لغيره ويرتحل عنه فيبقى حسابه عليه ونفعـه لغيـره، فيجمـع لمن لا يحمـده، ويقـدم على من لا يعـذره لكفـاه بـذلك ذماً للحرص؛ فالحريص يضيع زمانه الشريف، ويخاطر بنفسه في الأسفار وركوب الأخطار لجمع مال ينتفع به غيره.
النوع الثاني: من الحرص على المال أن يزيد على ما سبق ذكره في النوع الأول، حتى يطلب المال من الوجوه المحرمة، ويمنع الحقوق الواجبة، فهذا من الشح المذموم، قال الله ـ تعالى ـ: ((وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ)) [التغابن: 16].
وفي صحيح مسلم عن جابر ـ رضي الله عنه ـ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (اتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم: حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم)(17).
وإنما يصير حب المال مذموماً إذا كان سبباً في ارتكاب المعاصي أو ترك الواجبات، يقول شيخ الإسلام في هذا الصدد: (حب المال والشرف يفسد الدين، والذي يعاقب عليه الشخص هو الحب الذي يدعو إلى المعاصي مثل الظلم والكذب والفواحش، ولا ريب أن فرط الحرص على المال والرياسة يوجب ذلك، أما مجرد حب القلب إذا كان الإنسان يفعل ما أمر الله به ويترك ما نهى عنه، ويخاف مقام ربه، وينهى النفس عن الهوى؛ فإن الله ـ تعالى ـ لا يعاقب على مثل هذا إذا لم يكن معه عمل.
وجمع المال إذا قام فيه بالواجبات ولم يكتسبه من الحرام لا يعاقب عليه، لكن إخراج الفضل والاقتصار على الكفاية أفضل وأسلم، وأفرغ للقلب وأجمع للهم، وأنفع للدنيا والآخرة، وقد قال: (من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله، وجعل فقره في عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي راغمة)(18).
وينبغي التوسط إزاء المال بين الشره والانهماك عليه، وبين تركه والإعراض عنه؛ كما في حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فخطب الناس فقال: (لا والله ما أخشى عليكم إلا ما يُخرِج الله لكم من زهرة الدنيا)، فقال رجل: يا رسول الله! أوَ يأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم قال: كيف قلتَ؟ قال: يا رسول الله! أوَ يأتي الخير بالشر؟ فقال رسول الله: (إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً، أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس فثلطت وبالت، ثم اجترّت فعادت فأكلت، فمن أخذ مالاً بحقه بورك له فيه، ومن أخذ مالاً بغير حقه؛ فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع) متفق عليه.
وقد شرح ابن القيم هذا الحديث وبيّن المسلك الوسط تجاه المال فقال: (قوله: (إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يلم)) هذا من أحسن التمثيل المتضمن للتحذير من الدنيا والانهماك عليها والمسرة فيها، وذلك أن الماشية يروقها نبت الربيع فتأكل منه بأعينها فربما هلكت حبطاً، (والحبط انتفاخ بطن الدابة من الامتلاء أو من المرض)، فكذلك الشرِه في المال يقتله شرهه وحرصه، فإن لم يقتله قارب أن يقتله، وهو قوله: (أو يلم)، وكثير من أرباب الأموال إنما قتلهم أموالهم؛ فإنهم شرهوا في جمعها واحتاج إليها غيرهم، فلم يصلوا إليها إلا بقتلهم أو ما يقاربه من إذلالهم وقهرهم.
وقوله: (إلا آكلة الخضر) هذا تمثيل لمن أخذ من الدنيا حاجته، مثّله بالشاة الآكلة من الخضر بقدر حاجتها، أكلت حتى امتلأت خاصرتاها...
وفي قوله: (استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت) ثلاث فوائد: أحدها أنها لما أخذت حاجتها من المرعى تركته وبركت مستقبلة الشمس لتستمرئ بذلك ما أكلته. الثانية: أنها أعرضت عما يضرها من الشره في المرعى وأقبلت على ما ينفعها من استقبال الشمس التي يحصل لها بحرارتها إنضاح ما أكلته وإخراجه. الثالثة: أنها استفرغت بالبول والثلط ما جمعته من المرعى في بطنها فاستراحت بإخراجه، ولو بقي فيها لقتلها، فكذلك جامع المال مصلحته أن يفعل به كما فعلت هذه الشاة...
وفي هذا الحديث إشارة إلى الاعتدال والتوسط بين الشره في المرعى القاتل بكثرته، وبين الإعراض عنه وتركه بالكلية فتهلك جوعاً. وتضمّن الخبر أيضاً إرشاد المكثر من المال إلى ما يحفظ عليه قوته وصحته في بدنه وقلبه وهو الإخراج منه وإنفاقه ولا يحبسه فيضره حبسه)(19).
وإذا تقررت هذه الوسطية تجاه المال فإن على العلماء والدعاة خصوصاً أن يُعْنَوْا بتحقيق الكفاف والاستغناء عن الناس كما يُعْنَوْا بالزهد والتقلل من الدنيا؛ فإن استغناء العلماء عن الناس عموماً والحكام خصوصاً من أعظم الأسباب في حفظ مكانة العلماء وعظم شأنهم.
يقول سفيان الثوري ـ رحمه الله ـ: (لأن أخلّف عشرة آلاف درهم أحاسب عليها أحب إليّ من أن أحتاج إلى الناس... ولولا هذه الدراهم لتمندل بنا هؤلاء الملوك)(20).
يقول ابن الجوزي حاثاً على الاستغناء عن الناس: (ليس في الدنيا أنفع للعلماء من جمع المال للاستغناء عن الناس، فإنه إذا ضم إلى العلم حيز الكمال، وإن جمهور العلماء شغلهم العلم عن الكسب، فاحتاجوا إلى ما لا بد منه، وقلّ الصبر فدخلوا مداخل شانتهم وإن تأوّلوا فيها...
ولقد رأينا جماعة من المتصوفة والعلماء يغْشون الولاة لأجل نيل ما في أيديهم؛ فمنهم من يداهن ويرائي، ومنهم من يمدح بما لا يجوز، ومنهم من يسكت عن منكرات إلى غير ذلك من المداهنات، وسببها الفقر، فعلمنا أن كمال العز وبُعد الرياء إنما يكون في البعد عن العمال الظّلَمَة، ولم نرَ من صح له هذا إلا في أحد رجلين:
أما من كان له مال كسعيد بن المسيب كان يتجر في الزيت وغيره، وسفيان الثوري كانت له بضائع، وابن المبارك. وأما من كان شديد الصبر قنوعاً بما رزق ـ وإن لم يكفه ـ كبشر الحافي وأحمد بن حنبل؛ ومتى لم يجد الإنسان كصبر هذين، ولا كمال أولئك، فالظاهر تقلبه في المحن والآفات، وربما تلف دينه.
فعليك يا طالب العلم بالاجتهاد في جمع المال للغنى عن الناس؛ فإنه يجمع لك دينك، فما رأينا في الأغلب منافقاً في التدين والتزهد والتخشع، ولا آفة طرأت على عالم إلا بحبّ الدنيا، وغالب ذلك الفقر، فإن كان من له ما يكفيه ثم يطلب بتلك المخالطة الزيادة فذلك معدود في أهل الشّرَهِ، خارج عن حيّز العلماء)(21).
* والمقصود أن على العبد أن يقنع بالكفاف من هذا المال، مما يحتاجه في مطعمه ومشربه ومسكنه وملبسه ونحو ذلك، وأن يطلب ذلك من الله ـ تعالى ـ وحده ويرغب إليه فيه، وأن لا يكون سائلاً للمال بلسانه ـ إلا لضرورة ـ أو مستشرفاً إليه بقلبه.
وأما ما لا يحتاج إليه العبد فلا ينبغي له الاشتغال به؛ لأن ذلك يؤول إلى تعلق القلب بالمال واستعباده له، كما يفوت عمره في تحصيل رزق مقسوم، وقد يحمله الحرص على المال على اكتسابه بالحرام ومنع الحقوق الواجبة.
شهوة الرياسة:
شهوة حب الرياسة والمنصب إحدى الشهوات التي استعبدت كثيراً من الناس وأحكمت على أفئدتهم، فصارت الولايات والمناصب وما يتبعها من الشهرة والظهور مقصودهم ومرادهم.
وقد سبق إيراد حديث كعب بن مالك ـ رضي الله عنه ـ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (ما ذئبان جائعان أُرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه)(22).
يقول الحافظ ابن رجب ـ رحمه الله ـ في شرح هذا الحديث: (فأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن حرص المرء على المال والشرف إفساد لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم، بل إما أن يكون مساوياً وإما أكثر، يشير أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل، كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا القليل. فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا).
ـ إلى أن قال ـ: (وأما حرص المرء على الشرف فهو أشد إهلاكاً من الحرص على المال؛ فإن طلب شرف الدنيا والرفعة فيها، والرياسة على الناس والعلو في الأرض أضر على العبد من طلب المال، وضرره أعظم والزهد فيه أصعب؛ فإن المال يبذل في طلب الرياسة والشرف)(23).
ثم ذكر ـ رحمه الله ـ أقسام الحرص على الشرف فقال: (والحرص على الشرف قسمان:
أحدها: طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال، وهذا خطر جداً، وهو في الغالب يمنع خير الآخرة وشرفها وكرامتها وعزها. قال الله ـ تعالى ـ: ((تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُواً فِي الأَرْضِ وَلا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)) [القصص: 83]، وقلّ من يحرص على رياسة الدنيا بطلب الولايات فيوفق بل يوكَل إلى نفسه).
إلى أن قال ـ: (ومن دقيق آفات حب الشرف: طلب الولايات والحرص عليها، وهو باب غامض لا يعرفه إلا العلماء بالله العارفون به المحبون له....
واعلم أن حب الشرف بالحرص على نفوذ الأمر والنهي، وتدبير أمر الناس إذا قُصِدَ بذلك مجرد علو المنزلة على الخلق، والتعاظم عليهم، وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس وافتقارهم إليه، وذلهم له في طلب حوائجهم منه؛ فهذا نفسه مزاحمة لربوبية الله وإلهيته.
القسم الثاني: طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية كالعلم والعمل والزهد؛ فهذا أفحش من الأول، وأقبح وأشد فساداً وخطراً؛ فإن العلم والعمل والزهد إنما يُطلب به ما عند الله من الدرجات العلى والنعيم المقيم، والقربى منه والزلفى لديه...)(24).
ومما يؤكد خطر هذه الشهوة أن جنس بني آدم مولع بحب الرياسة والظهور، كما بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: (إن الإنسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس؛ رأى الواحد يريد نفسه أن تطاع وتعلو بحسب الإمكان، والنفوس مشحونة بحب العلو والرئاسة بحسب إمكانها، فتجده يوالي من يوافقه على هواه، ويعادي من يخالفه في هواه، وإنما معبوده ما يهواه وما يريده)...
إلى أن قال ـ: (فإن كان مطاعاً مسلماً طلب أن يطاع في أغراضه وإن كان فيها ما هو ذنب ومعصية لله، ويكون من أطاعه أحب إليه وأعز عنده ممن أطاع الله وخالف هواه، وهذه شعبة من حال فرعون وسائر المكذبين للرسل.
وإن كان عالماً أو شيخاً أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره، وربما أبغض نظيره حسداً وبغياً..)(25).
إن حب الرئاسة وطلبها لا ينفك عن مفاسد متعددة وشرور متنوعة، وقد أشار ابن رجب إلى بعضها بقوله: (واعلم أن الحرص على الشرف يستلزم ضرراً عظيماً، قبل وقوعه في السعي في أسبابه، وبعد وقوعه بالحرص العظيم الذي يقع فيه صاحب الولاية من الظلم والتكبر، وغير ذلك من المفاسد)(26).
وقال في موضع آخر: (إن حب المال والرئاسة والحرص عليهما يفسد دين المرء حتى لا يبقى منه إلا ما شاء الله... والنفس تحب الرفعة والعلو على أبناء جنسها، ومن هنا نشأ الكبر والحسد)(27).
وذكر ابن القيم ـ رحمه الله ـ بعض مفاسد هذه الشهوة، فقال:
(إن طلاب الرياسة ليسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض، وتعبّد القلوب لهم، وميلها إليهم، ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم، فترتب على هذا المطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والفتنة والحمية للنفس دون حق الله، وتعظيم من حقّره الله، واحتقار من أكرمه الله، ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تُنال إلا به وبأضعافه من المفاسد، والرؤساء في عمىً عن هذا؛ فإذا كُشف الغطاء تبيّن لهم فساد ما كانوا عليه، ولا سيما إذا حُشِروا في صُوَرِ الذرّ يطؤهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتصغيراً كما صغّروا أمر الله وحقروا عباده)(28).
وإذا تقرر ذم حب الرياسة وبيان مفاسدها، فإن حب الإمارة للدعوة إلى الله ـ تعالى ـ يفارق حب الرياسة؛ فإن مقصود هذه الإمارة تعظيم الله ـ تعالى ـ وأمره، وأما مقصود حب الرياسة فهو تعظيم النفوس والسعي في حظوظها، وأئمة العدل وقضاتهم لا يدعون إلى تعظيم نفوسهم البتة، بل إلى تعظيم الله وحده وإفراده بالعبودية، ومنهم من كان لا يريد الولاية إلا للاستعانة بها على الدعوة إلى الله وحده. فمن سأل ربه أن يجعله للمتقين إماماً يقتدي به المتقون، كما اقتدى هو بالمتقين لم يضره ذلك، بل يُحمد عليه؛ لأنه داعٍ إلى الله يحب أن يعبد ويطاع، فهو يحب ما يكون عوناً على ذلك موصلاً إليه (29).
إن على أهل العلم وطلابه أن يحذروا من شهوة حب الرياسة والشهرة، فإنه داء عضال ينبغي المسارعة في علاجه بالتوبة إلى الله ـ تعالى ـ وتزكية النفس ومحاسبتها.
يقول سفيان الثوري ـ رحمه الله ـ: (الرياسة أحب إلى القراء من الذهب الأحمر)(30).
وقد تحدث أبو الفرج ابن الجوزي عن أولئك العلماء المولعين بالرياسات والشهرة فقال: (واليوم صارت الرياسات من كل جانب، وما تتمكن الرياسات حتى يتمكن من القلب: الغفلة، ورؤية الخلق، ونسيان الحق؛ فحينئذ تطلب الرياسة على أهل الدنيا.
ولقد رأيـت مـن الناس عجباً حتى من يتزيا بالعلم، إن رآني أمشي وحدي أنكر عليّ، وإن رآني أزور فـقــيـراً عظّم ذلك، وإن رآني أنبسط بتبسم نقصت من عينه، فقلت: فوا عجباً هذه كانت طريق الـرسـول -صلى الله عليه وسلم- والصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، فصارت أحوال الخلق نواميس لإقـامـــة الجاه، لا جَرَمَ واللهِ! سقطتم من عين الحق، فأسقطكم من عين الخلق...
فـالتفِـتـــوا إخواني إلى إصلاح النيات، وترك التزين للخلق، ولتكن عُمدتكم الاستقامة مع الحق؛ فبذلك صعد السلف وسعدوا)(31).
وفي ختام هـــذه المقالة نسأل الله ـ تعالى ـ أن يرزقنا الهدى والتقوى والعفاف والغنى، وأن يجنبنا شهوات الغي ومضلات الهوى، وبالله التوفيق.
الهوامش:
(1) ذم الهوى، ص 498.
(2) ذم الهوى، ص 501، 502، باختصار يسير، وانظر ص 537.
(3) ذم الهوى، ص 546، 547، باختصار يسير.
(4) روضة المحبين ص 472.
(5) المرجع السابق، ص473.
(6) المرجع السابق 474.
(7) المرجع السابق، 478.
(8) المرجع السابق 479.
(9) المرجع السابق، ص481، 482.
(10) ذم الهوى، ص 483، 484.
(11) أخرجه ابن المبارك في الزهد، ص 189.
(12) سير أعلام النبلاء، 4/579.
(13) أخرجه أبو نعيم في الحلية، 2/152، وانظر: سير أعلام النبلاء، 4/576.
(14) الفوائد، ص 87-89، باختصار.
(15) عدة الصابرين، ص 185، 186، باختصار.
(16) مختصر الفتاوى المصرية، ص 29، وانظر: شجرة المعارف والأحوال، للعز بن عبد السلام، ص 7.
(17) شرح حديث (ما ذئبان جائعان...) ص 7-11، باختصار.
(18) مختصر الفتاوى المصرية، ص 493، وانظر ص 95، وانظر مجموع الفتاوى، 10/189، 190، ومختصر منهاج القاصدين، لأحمد بن قدامة، ص 195.
(19) عدة الصابرين، ص 198، 199، باختصار.
(20) أخرجه أبو نعيم في الحلية، 6/381.
(21) شرح حديث ما (ذئبان جائعان) ص 7، 13، باختصار.
(22) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
(23) شرح حديث (ما ذئبان جائعان)، ص 7، 13، باختصار.
(24) شرح حديث (ما ذئبان جائعان) ص 13، 15، 16، 20، باختصار.
(25) مجموع الفتاوى، 8/218،-باختصار.
(26) شرح حديث (ما ذئبان جائعان)، ص 14.
(27) المرجع السابق، ص 29.
(28) كتاب الروح، ص 433، 434.
(29) انظر: كتاب شرح حديث (ما ذئبان جائعان)، ص 19، وكتاب الروح، ص 432.
(30) كتاب الورع، للإمام أحمد بن حنبل، ص 91.
(31) صيد الخاطر، ص 227، وانظر ص 360، وانظر: أخلاق العلماء للآجري، ص 157.
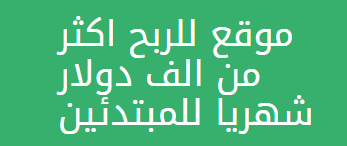
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق